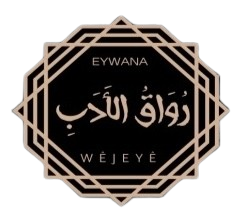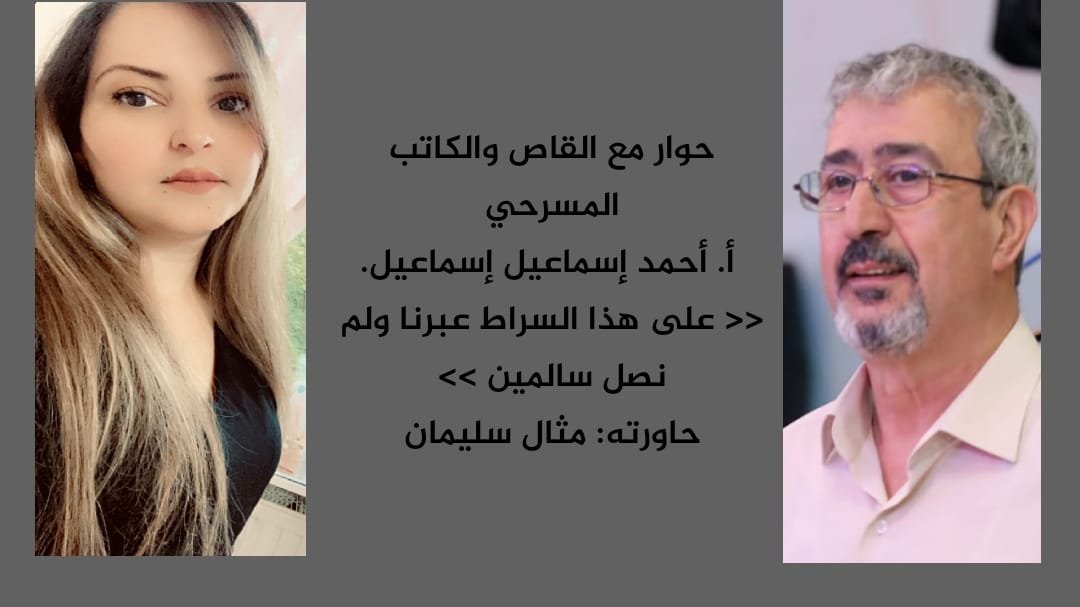الكاتب والناقد وها هو الباحث في مآلات الأدب كذلك، المواكب لحركة المسرح ما بين القديم والحديث في رغبةٍ لمحاكاة ما من شأنه أن يغلق روحه عليه وهو القائل: نقد الذات هو أمرٌ أصعب وأقسى من نقد الآخر. المسرحي الذي آمن بمقولة» المسرح فكر مشاع للجميع «
الحامل هموم ناسه وشعبٍ بكل أطيافه ليوقظ الوقت على ركح الحياة بقوله:» أنتم كذبة مررتم بذاكرتي، نسيتكم. أنا كذبة اقتحمت حياتكم، صفقتم لي»
طرحنا عليه عديد الأسئلة يقيناً منّا أنّه لم ينجح في إسقاط ما يزعجه من الذكريات من ذاكرته.
عن كل سؤال يقرّ بعصيان المسرح على الموت…
س1_ « فن الشعر»
كتاب أرسطو الأسطوري «فن الشعر» لاستلهم منه سؤالي الأول حول المسرح والمؤسس على نظرية أرسطو «ما الشعر إلا محاكاة للواقع من خلال الإيقاع والانسجام واللغة»
أ. حسو الناقد المسرحي كيف يقيم نظرية أرسطو، هل من شأن المسرح أن يحاكي الواقع والعالم كالشعر كما يريد أم يبقى مجرد لعبٍ بما هو ساكن في أعماق الذات الإنسانية؟
••يعتبر كتاب فن الشعر المرجع الأول في النقد المسرحي حتى الآن في الأكاديميات العالمية رغم محاولات تقويضه وزعزعته منذ هوراس ولونجانيوس مروراً بدينس ديدرو وليس انتهاءً بمسرح العبث والمسرح الملحمي. هجرت هذه النظرية من موطنها الإغريقي وارتدت لبوسًا عالمياً، تجولت بين الثقافات وحاولت أن تقلص الحدود الثقافية بينها.
أضاءت النظريات التي أُنتجت فيما بعد جوانب عديدة من نظرية أرسطو (فن الشعر)، تلبيةً لاحتياجات المجتمع والمرحلة التاريخية، لكن كتاب (أرسطو مصاص دماء المسرح الغربي) للفرنسية فلورانس دوبون، جمع بين طياته رؤىً جديدة تعارض أدبية النص المسرحي الأرسطي المرتبط بقيود الفلسفة (التراجيديا، المنطق الدرامي، السرد الحكائي، التطهير..)، وترتهن لمنطق الاحتفال الطقسي والتمظهرات الشعبية. بدورنا نطرح سؤالاً هل المسرح أدب أم فن؟.
لم تخرج النظريات المسرحية التي ظهرت فيما بعد من معطف أرسطو بما في ذلك المسرح الملحمي، وكأنها سلسلة متتالية من المتحولات تتحول في كل مرحلة وتمنح صفة توحي بأنها معارضة لأرسطو، لكنها تؤكد حضوره. فمثلاً، كسر شكسبير وحدة الزمان والمكان، كما دمج التراجيديا مع الكوميديا في نص مسرحي واحد… وألغى ديدرو الجدار الرابع.. وأضاف بريشت إلى العرض وظيفة تنويرية، تحريضية.
التراجيديا لا تمثل أشخاصاً، بقدر ما تمثل أفعالاً، لأن الحكاية في ذاتها ليست درامية بقدر ما هي حكاية سردية، وكذلك الشعور والإحساس في ذاتهما ليسا درامياً، فمهمة الدراما ليس إبراز العاطفة، بل إبراز عاطفة تؤدي إلى عمل، من هنا يمكن الاصرار على أن الفن محاكاة للواقع، محاكاة الأفعال الإنسانية، حيث يقوم عمل الفنان على تمثيل الواقع كما ينبغي أن يكون، وليس نقلاً أو تصويراً أو انعكاساً للواقع، المؤرخ يروي ما وقع بالفعل، في حين أنّ الفنان يروي ما يتوجب وقوعه، بمعنى مقتضى الرجحان والضرورة عند أرسطو.
س2_ «المسرح والنقد» هل من طقوسٍ يستند عليها النقد المسرحي؟ النقد المسرحي هل معرض إلى التغيير من زمنٍ لآخر؟
••هل المسرح أدب أم فن؟!! هنا تكمن إشكالية تعامل النقد مع المنتوج المسرحي، بمعنى كيف يتعامل النقد مع المسرح كنص أو كعرض، علماً أنهما مختلفان من حيث القراءة النقدية وحضور المتفرج. لكن جميع من تعامل مع الكتابة المسرحية النقدية كانوا صحفيين أو نقاد أدب، قدموا من حقل الأدب واستخدموا أدواته، كتبوا نصوصاً مسرحية وإذاعية وتلفزيونية، كما مارسوا النقد المسرحي لحداثة هذا الفن في سورية منذ الستينيات، ولعدم وجود نقاد أكاديمين، استمر الوضع هكذا حتى تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية، لدرجة أن اسم القسم (قسم النقد والأدب المسرحي)، والمؤسسة المسرحية الرسمية التي تسمى مديرية المسارح والموسيقا أيضاً، لم تعترف بوظيفته منذ أن وجدت هذه المؤسسة. لن أتطرق إلى الجوائز في جميع حقول الأدب والفن والصحافة باستثناء النقد والناقد المسرحي، ولن أتطرق إلى العلاقة المتوترة بين المؤسسة المنتجة للعرض والناقد المسرحي. رغم أهمية النقد المسرحي في الحياة المسرحية، فهو محارب من جميع المؤسسات الثقافية الرسمية ومن معظم المخرجين والممثلين.
يُفترض أن يكون الناقد المسرحي في النقد التطبيقي على العروض المسرحية، ملماً بذهنية المؤلف، وآلية عمل المخرج، وحساسية الممثل وحركيته، وتقنية المصممين وذهنية المتفرج بالقوة إلى أن يتحول وجوده بالفعل، وكونه الناقد، فهو يرى بعيون كثيرة ومن زوايا عدة بعيداً عن الذاتية، لأنه صوت المجتمع/ الرأي العام.
إذا كان النقد المسرحي هو القراءة الواعية للعرض يقوم بها متفرج يملك بعض مفاتيح الدخول إلى متن العرض، فمن الضروري أن هذه القراءة تتطور وتتغير وفق الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ومن زمن إلى آخر ومن قارئ إلى أخر في حال توفرت حرية الرأي. أخيراً يتجدد أدوات النقد المسرحي مع إنتاج كل عرض جديد.
س3_ «الجمالية الفنية على المسرح»
هذا عنوان مقالٍ لحضرتك حول منهج ستانسلافسكي في الملحق الثقافي للثورة في الثالث عشر من تشرين الثاني 2012 كتبتً:( في كتابه «حياتي في الفن» ربما يضاهي كتابه فن الشعر لأرسطو والذي يقول فيه: (أخلق منهجك الخاص) رغم أنّه طور منهجه وطوعه ليلائم أمزجة وشعوباً متباينة، هل كان من شأن هذا أن يكون له تأثيراً في المسرح السوري وجذب المتفرج إليه؟ وهل من مسرحيّ سوري حاول إيجاد منهجه الخاص ليؤثر ويتأثر به مسرحٌ آخر؟
••لاشك أن ستانسلافسكي طرح نظريته مع نيمروفيتش داتشينكو بعد التجارب الطويلة في فن التمثيل والذاكرة الانفعالية وقراءة النصوص والممارسة اليومية التي يقوم بها هو وفريقه التمثيلي إضافة ملاحظاته المستمرة حول الطبائع البشرية، بالنسبة لكتاب (حياتي في الفن) ترجمه د. نديم محمد، كنت مطلعاً على تفاصيل الترجمة منذ اللحظة الأولى للترجمة حتى نشره.
يعتمد منهج ستانسلافسكي على أمور عديدة مثل خط الفعل المتصل للوصول إلى الهدف الأعلى للعرض المسرحي أو الهدف الأعلى للشخصية المسرحية من خلال الذاكرة الانفعالية، والصدق الداخلي والوعي الباطني، فالأشياء والحركات على الخشبة لها هدف ودلالة تتحول إلى فعل. يحذر ستانسلافسكي الممثل الذي يبحث في الشخصية التي يؤديها عن الجانب المناقض لهدفه المعلن، مثلاً عندما يؤدي شخصية العجوز، يجب أن لا يغيب عن باله شخصية الفتى، وعندما يؤدي الممثل شخصية المريض عليه أن يفكر بالجانب المتعلق بالصحة والعافية، وهكذا.
يُدرس منهج ستانسلافسكي حتى الآن في جميع معاهد التمثيل والسينما، وهو المنهج الرئيسي في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق والمعاهد الخاصة أيضاً، لذلك كان تأثيره قوياً على جميع الممثلين في المسرح واستفاد منه ممثلو السينما والتلفزيون بوصفهم كانوا ممثلين في المسرح. لا أعتقد أن أحداً من المخرجين السوريين حاول أن يجد منهجاً متكاملاً في فن الممثل خارج إطار ستانسلافسكي وبريشت متماشياً مع خصوصية البيئة، لكن جميع المسرحيين حاولوا مراعاة الواقع والمرحلة التاريخية بما يخص المتفرج، مثل تجربة المسرح الخلاق، ومسرح الصورة في عروض مانويل جيجي وجهاد سعد، والمسرح الاحتفالي في عروض تامر العربيد والمسرح التراثي في بعض نصوص عبد الفتاح قلعجي والفنون الأدائي.. فمثلاً كان الممثل يتكلم العربية الفصحى في العروض المسرحية، استُبدلت باللهجة المحكية (الثالثة) في العروض اللاحقة، حاول فواز الساجر أن يقدم نظرية عربية متكاملة مستفيداً من نظرية ستانسلافسكي في رسالة الدكتوراه.
س4_»تأصل المسرح؛ إغريقي»
تواجد الإغريق (اليونانيون) في مصر في القرن السابع قبل الميلاد واحتلوها أكثر من 970 عاماً وهم أهل المسرح، لمَ ربطت ظهور المسرح فيها (مصر) بحملة نابليون في نهاية القرن الثامن عشر؟
••كان للإغريق علاقات طيبة مع مصر ودول شرق اسيا، وأنشأ الرومان العديد من المسارح في سورية، يدل هذا على وجود حركة مسرحية نشطة في العهد الروماني، كذلك عرف العرب المسرح بصيغته الأرسطية أثناء احتلالهم الأندلس، ورغم ذلك لم يتعاملوا مع هذا الفن إلا في منتصف القرن التاسع عشر.
كانت مصر مهيأة لاستقبال الثقافة الأوروبية الجديدة التي أحضرتها القوات الفرنسية أثناء حملة نابليون، فأدرك الجبرتي أهمية تلك الثقافة الوافدة ودورها في حياة المجتمع، وقال العطار إنّ بلادنا لابد أن تتغير أحوالها، ويتجدد بها من العلوم ما ليس فيها.
كما أن مارون النقاش الذي عمل في التجارة اعتبر أن المسرح بضاعة جديدة، فأحضر معه المسرح من أوروبا وعندما لاقى إقبال أهالي بيروت من الأعيان والتجار عليه، ألقى خطبته الشهيرة قبل العرض، وأسس لهذا الفن الجديد. خلاصة القول، ارتبط وجود المسرح في البلدان العربية بالطبقة البرجوازية.
س5_» النص المسرحي»:
كونه واحدة من سمات هوية المسرح، أصحيحٌ من شأنه أن يتحول إلى طاغية ينقل الصراعات من الواقع إلى صلب الحياة، ليغدو المسرح عرضاَ لعضلات الشر؟ وماذا عن ترجمة النص المسرحي، هل حافظ على كماله وهويته بعد ترجمته للعربية وتوليفها لتناسب المتفرج العربي؟ هل بالإمكان تحديث القديم من النصوص؟
••صراعات النص المسرحي هي صراعات افتراضية على الصفحات وفوق خشبة المسرح، لأن العملية برمتها تمثيل، إن كان النص محلياً أو مترجماً. هذا ما نقول لنص أجنبي تُرجم إلى العربية وظل محافظاً على سماته وعلاقاته! أما العرض المسرحي يحدد هوية المسرح، لأنه يُقدم لجمهور الآن، وفي هذا الوقت(هنا/ الآن ).
من هنا نجد أن لمفهوم المعاصرة خاصية أصيلة في أعمال الكتاب المبدعين، تتدخل قراءة المخرج التأويلية بحيث تنطلق من رؤى معاصرة تنزع نحو إعادة إنتاج نصوص الماضي وفقاً لمعطيات الحاضر، العروض المسرحية هي معالجات وإضاءات لقضايا الإنسان المعاصر. انشغل رجال المسرح بهوية المسرح أو قومية المسرح وتجذيره في الواقع في مرحلة التحرر الوطني وبناء الدولة والتشبث بالأيديولوجيا القومية رداً على المشاريع الغربية.
النص المسرحي كان مهيمناً في العملية الاخراجية ليكون نصاً أدبياً شعراً أو نثراً في مرحلةٍ ما، تغيرت النظرة الى النص المسرحي ليصبح مجرد اقتراح للإخراج، ثم تراجعت أهميته مع تيار المابعديات، لدرجة أنه نادراً ما يُطبع في كتاب.
الأشكال المسرحية هي حصيلة تطور رؤى حضارية واجتماعية وثقافية، ألم يكن المسرح الاوروبي المعاصر هو حصيلة أشكال ومشهديات العالم؟!. أليس لكل شعب شكل تراثي مستمد من الواقع؟!
تتعرض جميع النصوص العربية والأجنبية لصياغات معاصرة تلبية لاحتياجات المجتمع والمتفرج، فمثلاً مسرحية (ميديا) ليوربيدس المأخوذة من أسطورة ميديا، تعرضت للتغييرات منذ صياغة يوربيدس وحتى الآن على يد الكتاب والمخرجين، وعرضت (هاملت) على معظم خشبات المسارح في العالم بصياغات مختلفة ومتنوعة، وكذلك أوديب ملكاً وأنتيجون وروميو وجولييت وفي انتظار غودو…
س6_ « المكان وديناميكية المسرح»
عن الثالوث المسرحي ( الجمهور، الركح والممثل) أي سرّ يكمن في معايشة أحدهما للآخر؟ إن كان الجمهور يحتاج لقاعة آمنة للاستماع والمشاهدة، في حين نظره متعلق بحركة الممثل والممثل كذلك يحتاج لمنصة عرضٍ آمنة ومريحة؛ ليتحكم هو بحركته وإنجاز دوره على أكمل وجه. أية أهمية يمنحها المكان للمسرح؟ ماذا عن مسرح الشارع للعروض المبتكرة، جمهوره العشوائي والعرض في الهواء الطلق؟ ما أوجه التقاطع والاختلاف بينهما؟
••ستشمل التغييرات الثالوث الإبداعي دون الاستغناء عنها، فمثلاً المكان هو المساحة المؤطرة التي يسمح للممثل التحرك عليها بغض النظر إن كانت المساحة علبة ايطالية أو حديقة أو ساحة أو شارع، ولا يتجاوز خارج المنطقة المحددة، وشخص آخر يقف أو يجلس أو يركض أو يأكل أو يفعل أي فعل، فهو يراقب اللاعب المتحرك، يشاهده، يتفاعل معه أو لا، يسمى بالمتفرج. وقد لا يكون المتحرك ممثلاً ربما رياضياً أو عازفاً أو مغنياً.. هذه العلاقة بين المثلث الإبداعي يجب أن تكون متناسجة دائماً.
لا يختلف مسرح الشارع عن المسارح الأخرى إلا في حدود قدرات الممثل الصوتية والأدائية وانتقالاته من فسحة إلى أخرى، وبالنسبة للمتفرج في مسرح الشارع ثمة نموذجان، متفرج يشاهد بشكل مستمر جاء ليشاهد هذا العرض وغيره من العروض في الشارع، بينما الآخر متفرج طارئ، لم يصمم أن يشاهد العرض، لكنه شاهد بالصدفة. في النموذجين هو متفرج لا يجلس على مقاعد خاصة بالعرض. هذا الجمهور نجده أيضاً في المهرجانات المسرحية، وعروض تخرج طلاب المعاهد، قد يحضر أحد العرض لأن صديقه ممثل فيها أو أن سمع أن العرض يلبي رغباته، أو لديه كثير من الوقت للذهاب إلى قطعته العسكرية.
س7_ «عامل الزمن»
« الزمن في القصة أو الرواية متباطئ، تسير الساعة ببطءٍ وقد تكتئب» ماذا عن الزمن لدى الشخصية المسرحية، كيف يتحكم الكاتب المسرحي بالزمن النفسي وهو يبث المشاعر والأحاسيس في روح الشخصية ويسيرها؟ هل من شأن هذا الزمن أن يخلق الانتظار والقلق لدى المتفرج؟ أم برأيك هو يبحث في قيم أسمى؟ في النهاية هل هدف الكاتب أن يبلغ المتفرج بعد طول انتظار مآله والنفاذ من واقعه الأليم أم يترك المقعد دون أمل.. ؟
هدف المخرج من العرض المسرحي أو من الفن المسرحي بناء عالم تتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية، لذلك يستخدم جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه.
طبيعي أنّ لكل نص مسرحي إيقاعه الذي يخلق المتعة أو الملل في حال لم يأخذ الفعل الدرامي مداه الزمني، وهو ما يشجع المتفرج لمتابعة العرض أو لا. لكل شخصية إيقاعها الخاص بها في التعامل مع الشخصيات والأحداث، مثلاً تتميز نصوص تشيخوف بالصمت (لحظة)، هذا لا يعني أن جميع الشخصيات تمتاز بهذه السمة، قد تختلف قيمة الزمن من عرض مسرحي إلى آخر للمخرج نفسه، وتعرضها للعديد من التحولات الزمانية، والعلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل هي علاقة مختلفة عند جميع الشعوب وفق فلسفتها ورؤيتها للحياة، فمثلاً، فكرة الامتداد الزمني المنفصلة عن الزمن الروحي في الغرب، والمتصلة بالزمن الروحي عند الإسلام والشرق والمختلف عنه لدى المتصوفة، تنعكس نتائجها في العمل المسرحي، وأية محاولة لتوحيد الزمن في المسرح هي محاولة فاشلة سببها أن الزمني متلازم مع الروحي في الشرق ومنفصل عنه في الغرب.
إن أية قيمة أخلاقية موحدة في المسرح هي كسر خصوصية الشعوب والأمم، فمثلاً اختلاف الزمن في مسرح (النو) الياباني عنه في مسرح تشيخوف وعنه لدى بيكيت ولوركا، ولدى وليد إخلاصي وغيرهم، هذا الاختلاف مرتبط عند الكاتب بارتباطه بالمجتمع وفلسفة الحياة رغم أن بعض هؤلاء الكتاب تنتمي نصوصهم إلى الصيغة الأوروبية غير المتجانسة فيما بينها، وبعض النماذج تنتمي إلى حضارات لها جذور دينية وميثولوجية مختلفة، وتناول الزمن في هذه الحالة مختلف في (الآنسة روزيتا العانس) عنها في (في انتظار غودو) وعنها في (بستان الكرز)، وعنها في (أنشودة الحياة)، والانتظار في هذه النصوص، باعث عن القلق والتوتر في حياة المجتمعات.
س8_ «الأزياء» « كانت الأزياء منذ بداية العروض المسرحية الأولى رمزية دلالية واقعية تزيينية»
ما مدى تأثير الأزياء على المتفرج؟ دورها في المشهد المسرحي مجملاً؟ وهنا ثمة سؤال راودني: الزي المسرحي هل يسير في منحى تطور الأزياء في الحياة الاجتماعية؟ هل يمكن لأوديب أو هاملت اليوم ارتداء أزياء غير تلك المتعارف عليها قديماً؟
••للأزياء أهمية كبيرة في العروض المسرحية، وإذا تجاوزنا أن الزي يستر جسم الممثل إن كانت الشخصية نمطية أم دينامية، فإنه يجذب انتباه المتفرج الذي كان يعارض الزي أفق انتظاره، بمعنى أن المتفرج كان يتوقع أن يشاهد نموذجاً خاصاً للزي (أزياء تاريخية، أزياء الملك، أزياء الفارس، أزياء الأميرة أو الفقيرة)، لكنه يتفاجأ بزي آخر مختلف عما كان يتوقعه، كمثال يرتدي الممثل الذي يؤدي شخصية هاملت بنطال شارلستون في السبعينيات، أو يرتدي (شورت أخضر) في التسعينيات وهكذا.. كما أن شخصية العاشق ترتدي جلباباً (جلابية) أو شروالاً، أو بنطال جينز يرتديه رجل الدين.. وفي حال الكوميديا تكون الازياء بالضرورة غير منسجمة ذات ألوان فاقعة لإثارة الضحك دون مرجعية لها.
إن تأثير الأزياء كبير على الناس وقد يكون الممثل يوماً ما وسيلة لترويج البضائع لصالح الشركات المحلية أو العالمية، ويمكن استغلال هذا الموضوع بأن يغير في رغبات الناس وفي أشكالهم والهدف منها تحسين الذوق وتنميته.
إن للأزياء تأثيراً على المجتمعات والأفراد بحيث تعكس الموضة، والفن كوسيلة، تروج هذه البضاعة من خلال الشركات التجارية في البلدان الأجنبية، مثلاً الفتيات يرتدين فساتين صوفيا لورين، وتنانير كاسندرا، وتسريحة الممثلة الفلانية، وكذلك الرجال يصنعون شكل شواربهم كالممثل مارشيللو ماسترياني مثلاً أو تسريحة الممثل الفلاني.
س9_ Brecht والمسرح الملحمي..
بعد اعتراض بريخت/ بريشت على نظرية أرسطو المؤسسة على محاكاة الواقع حيث رأى في المسرح رسالة اجتماعية وسياسية لابد أن يستفيد منها المجتمع وناقش الواقع مناقشة ديالكتيكية بقصد تنوير الجماهير بحقائق هذا الواقع. لكم تجربة باتجاه الملحمة، دراسة، ملحمة درويش عفدي المغناة والشفهية الكردية والتي تثبت فيها تعددية الثقافات المحلية في الروايات، ما المقصود من قولكم في توصيف الكتاب: لكل سؤال عديد الأجوبة؟ لم اقتصرت التجربة على الدراسة والبحث؟ ألم يكن المسرح البيئة الأنسب لها؟ هل سيتصدر مم وزين أو درويش عڤدي يوماً البطولة المسرحية على غرار الأساطير والملاحم العالمية؟
••يحتمل السؤال عدة أجوبة في سياق الدراسات الثقافية التي تتخذ من النسبية منهجاً فيما إذا تجاوزنا المنطق اليقيني، وأيديولوجية النمط الوحيد الواحد في مركزية الحداثة الأوربية .
المسرح الملحمي يختلف اختلافاً جذرياً عن الملحمة كنوع أدبي مثل (الألياذة،والأوديسة، والمهابهاراتا) يعتمد على الإنشاد، في حين أن المسرح الملحمي يعتمد على السرد، يقوم الراوي بأدائه.
أعتقد أن معظم ملاحمنا الكردية التي تُروى وغالباً تُغنى ليست أقل أهمية من الناحية الفنية والتخييلية والاجتماعية من الملاحم العالمية، ولا تختلف ملحمة دوريشي عڤدي عن معركة ترموبيله أو (أسطورة 300 فارس إسبارطي). لكن الإشكالية تكمن في التماثل الثقافي عندما تحين ظروف مجتمع ما أو يمر بتطور اجتماعي فتظهر تجلياته على شكل أغنية ملحمية.
لا يمكن نقل تجربة مسرحية من بيئة ثقافية إلى بيئة ثقافية أخرى بكل حرفيتها مع الحفاظ على نجاحها، كان يجب أن تبتدع مسرحاً من البيئة التي تعيش فيها متحاوراً مع تجربة الآخرين. دون نسيان وظيفة المسرح عند بريشت التي تتساوق مع المرحلة التي كان يعيش فيها، فإذا كانت رسالة المسرح عند بريشت تنويرية، سياسية ، ثورية، فرسالة ارسطو أخلاقية، بينما لا يعترف مسرح العبث برسالة المسرح أو وظيفته، كما يقول بيكيت بأنه ليس ساعي بريد يوزع الرسائل.
س10_ كلّ حربٍ وكل ثورة من شأنها أن تغير من الوعي السياسي والاجتماعي؛ لانهيار القيم المتعارف عليها وقد تطال الجانب الثقافي كذلك. الثورة السورية أتاحت الفرصة للكثير من الفنون لتخطي الرتابة والرقابة. ماذا بشأن المسرح وهو أبو الفنون، هل ظهرت أنواع مسرحية جديدة من شأنها السعي لتجاوز الإيديولوجيا إلى فضاءات أكثر اتساعاً وجدية؟ بعد أن كان البعث ولحقبة من الزمن مخولاً بتكوين أيديولوجيا خاصة بالمسرح السوري ومسيطراً على طاقاته النقدية؟ هل عاد لسوريا مسرحها؟
••المسرح يخضع لمؤسسة ثقافية إدارته بيروقراطية يمكن توصيفها بأنها مؤسسة خاملة، فهي غير منفعلة ولا فاعلة، فالمؤسسة الثقافية تتبع لنظام سياسي، وهو بدوره خاضع لرقابة صارمة، ومهمة الرقابة سياسية بالدرجة الأولى وليست فنية، لذلك لا ينظر إلى الأمور الفكرية أو الفنية أو التعليمية بأي اعتبار حتى لو كان النص المقدم مجرد شعار فارغ، فتصور كيف ستكون النتيجة.
لم يستطع المسرح خلق جمهور مسرحي يتقبل المسرح بكل أشكاله، ويطالب بحقه في المشاهدة، والجمهور الذي نراه يتزاحم على بعض العروض، هو جمهور طارئ، ولعرض محدد ولسبب محدد. لا يختلف وضع المسرح بين أن يكون أداة تغيير أو أن يكون أداة تعبير. إنه كأداة تغيير، يعتبر أداة نضالية لها بعد استراتيجي في التغيير الاجتماعي والسياسي، لكن حدث أن ظهر أشكال فنية جديدة كفنون الأداء.
س١١_ ما الذي خلق بذرة المسرح لدى الناقد والباحث عبد الناصر حسو، كيف تعرّف عبدالناصر حسو الكاتب والباحث والناقد والمترجم؟
••لم تكن دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية بهدف الحصول على شهادة جامعية للتوظيف ولا للمنفعة المادية بقدر ما كان إشباعًا لرغبتي في اكتساب المعرفة في إطار التخصص وبإشراف خيرة الأساتذة في المعهد عام 1986، لقد كنت قارئاً عشوائياً، بمعنى لم تكن شهادة المعهد تهمني ولا التوظيف على أساسها لأنني كنت قد حصلت على شهادة جامعية قبل ذلك بخمس سنوات وتوظفت على أثرها، لكن بعد إطلاق سراحي من المعتقل وحرماني من الحقوق المدنية، كنت مضطراً للعمل في مجال النقد المسرحي في الصحف والمجلات العربية.
س11_” اليزيدية وفلسفة الدائرة”
كتاب عن الديانة اليزيدية والغموض الذي يكتنفها. هل استطعت أن تزيل الحجاب عن معتقدك الديني وتهز شجرة مآسي هذه الديانة وآلامها؟
ـ لا أحد يستطيع أن يحدد الغموض الذي اكتنف الايزيدية كي يزيلها، وهذه إشكالية الأديان جميعها، لكن غموض الايزيدية مختلف، وليس مرتبطاً بحملات الإبادة، قد يكون الغموض في طرح الأسئلة التي تمس جوهر الدين، أو في طرح السؤال، هل الايزيدية ديانة مغلقة لا تقبل التبشير؟ ولماذا؟. ولو حاولنا الدخول في المتوالية الهندسية التي ترتفع إلى المؤسس الأول (الرجل والمرأة)، كيف اعتنقا الايزيدية؟ رغم ذلك لا يمكن القول إنها غير تبشيرية، أو يكتنف الغموض في العلاقة المباشرة مع الله دون وسيط (الرسول)، من هنا كان على الايزيدي الاحتكام إلى العقل في اختيار الطريقة التي ينتهجها في الحياة، فاختيار الطريق الصحيح واتخاذ القرار الصائب، هي المتعة الحقيقية في التقرب إلى الله.
المجتمع الإيزيدي في دائرة تقاليده وأعرافه وقوانينه وثقافته وعلاقاته لا زال مجتمعاً يتأرجح بين الانغلاق والانفتاح، تسوده قيم أخلاقية، ليبدو الانغلاق ناتجاً عن مجموعة عوامل داخلية وعوامل خارجية، غايتها الوصول إلى الحقيقة، حقيقة الإيزيدية واستمراريتها.
صاغت الايزيدية أسئلتها المعرفية والروحية بوعي فطري لحقيقة وجودها المهدد بالقتل في كل لحظة، وفي محيط مختلف كحامل اجتماعي بصيغته الإنسانية وحضوره/ نفيه في القوانين التشريعية للأحوال المدنية، فشكلت خصوصية ضمن خارطة دينية، لغوية، أخلاقية، روحية محكومة بصراع المكونات في فضاء المعتقدات المتواجدة معها، والتي لا تتحدى ديناً بقدر ما تسعى للعبور بتركيبتها اللاهوتية (الله، طاووس ملك، ايزيدا)، وطبقاتها الدينية الثلاث (البير، الشيخ، المريد) إلى فضاءات التعايش للحفاظ على كينونتها الإنسانية والدينية، رغم أن الطبقات الدينية الثلاث تتعرض لهزات عنيفة من داخل البيت الايزيدي بين حين وآخر للبحث عن سند ديني من المجلس الروحاني، وللسعي إلى التكيف ومواكبة التطورات المتسارعة في العالم رغم أن بعضاً من إيزيدية عفرين يتجاوزون الطبقات الدينية الثلاث في قانون الزواج.
ـ ناقد وباحث مسرحي كردي من منطقة عفرين (قرية عرشقيبار)، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. يقيم حالياً في المانيا
-عمل بصفة مدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية
ـ كتب العديد من الأبحاث والدراسات المسرحية في الدوريات العربية والسورية المتخصصة، منها (مجلة الحياة المسرحية، مجلة المسرح العربي، مجلة المسرح، مجلة كواليس، مجلة المشهد المسرحي، مجلة مسرح العالم بالفرنسية (افينيون)، مجلة قلمون، مجلة الموقف الادبي، مجلة المعرفة، مجلة البيان…)
ـ الكتب المنشورة
ـ احلام العجائز، مسرحية باللغة الكردية، 1989.
ـ رسالة المحبة، للأطفال، 1998، عرضت على خشبة المسرح القومي بطرطوس.
ـ غندور وفرفور، مسرحية للفتيان، 1999
ـ الحداد لا يليق بك، مسرحية بالكردية، 2015.
ـ اليزيدية وفلسفة الدائرة، ط1، 1998، خاص، ط2، دار التكوين 2008.
ـ أيام دمشق المسرحية، دمشق ج1و2، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2004
ـ مهرجانات دمشق المسرحية في جزئين، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2006.
ـ الحركة المسرحية في التسعينيات في سورية، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2008
ـ مفردات العرض المسرحي، دمشق، سورية، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2010
ـ المسرح العربي وحوار الحضارات، مجموعة مسارح الشارقة، الشارقة، 2010.
ـ خزانة ذاكرة، مهرجان دمشق للفنون المسرحية، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، 2020.
ـ ملحمة دوريش عفدي المُغناة والشفهية الكردية، دار خطوط وظلال، عمان الاردن 2021.
دراسات مسرحية ضمن كتب بالاشتراك مع آخرين
ـ كتاب: مسرح الطفل في سورية، المسرح والعلوم (نصوص من الشرق إلى الغرب)، المسرح الجامعي في سورية، المسرح القومي في سورية، المسرح التجريبي في سورية، مسرح المونودراما في سورية
– الأخوة الأعداء، باللغة الكردية، مطبعة خاصة، 1988.
ـ الصرخة، باللغة الكردية، مطبعة خاصة، 1995.
ـ أشرف على توثيق المسرح السوري منذ البداية في وزارة الثقافة، لكن المشروع لم ير النور لأسباب عدة.
ترجم مجموعة كتب ومقالات تحت اسم مستعار (هورامي يزدي)، بالنسبة لمذكرات أوسمان صبري وأعمال قدري جان، كانت هذه الترجمة هي الاولى إلى العربية.
ـ مذكرات اوسمان صبري، بيروت، لبنان، 2001،
ـ أعمال الكاتب قدري جان ط1، بيروت، لبنان،2000 ط2، أربيل كردستان العراق، مطبعة اراس، 2001. تحت اسم مستعار (هورامي يزدي) هذه الترجمة الاولى لأعماله إلى العربية.
ـ (ممى آلان) حكاية فلكلورية، روجيه ليسكو، دار التكوين، دمشق، سورية، 2006.
ـ مسؤول الصفحات الثقافية وسكرتير تحرير مجلة (الحرية) ومجلة (حق العودة) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ـ عضو هيئة تحرير مجلة (الرؤية)، مجلة (أوراق) للمعارضة السورية في الخارج.
ـ مسؤول قسم المسرح في جريدة شرفات الشام التابعة لوزارة الثقافة.
ـ مدير تحرير مجلة (الحياة المسرحية) الصادرة عن وزارة الثقافة في سورية
ـ عضو تحرير مجلة (المنصة) لمهرجان دمشق للفنون المسرحية منذ 2004.
ـ شارك في العديد من العروض المسرحية في مديرية المسارح كاتباً، ممثلاً، دراماتورجاً، مخرج مساعد ومساعد مخرج، مدير منصة، ناقداً مسرحياً وإعلامياً.
ـ شارك العديد من المهرجانات دمشق المسرحية في سورية ومهرجانات الهواة والشباب في جميع المحافظات السورية، ومهرجان المسرح العربي في الشارقة، ومهرجانات الفنون الشعبية في ادلب.
ـ قدم العديد من الدراسات والابحاث النظرية في الندوات والملتقيات الثقافية والمسرحية
ـ قارئ نصوص الأطفال في الهيئة العامة السورية للكتاب.
ـ محكّم للدراسات المسرحية في بعض الدوريات التي تخصص (المسرح) ملفاً في عدد خاص.