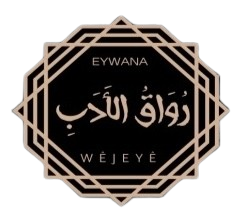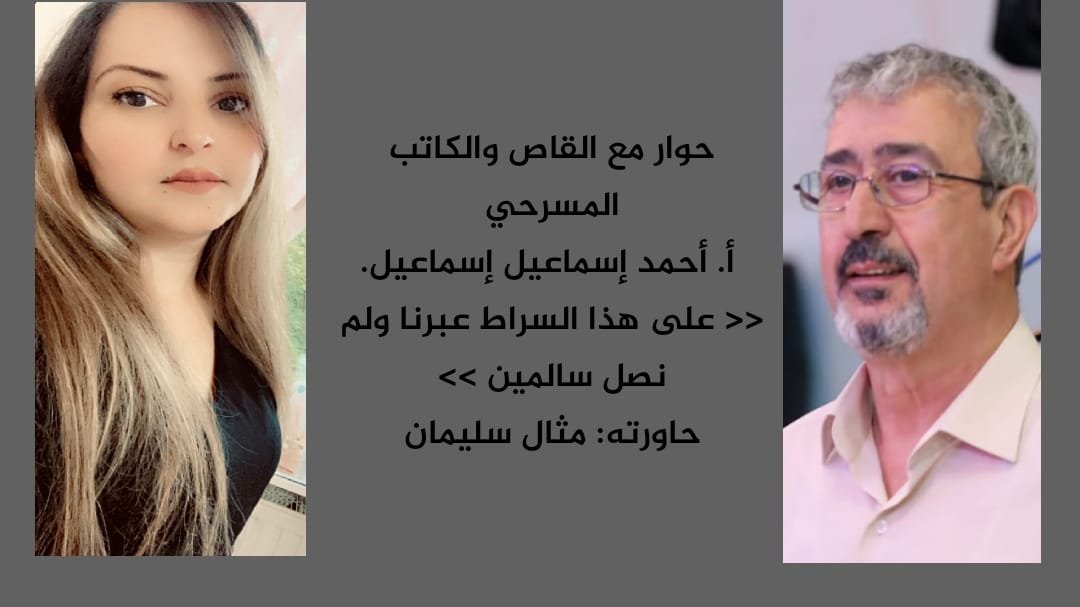“إحساسي بأنّ العمر حفنة ماءٍ تتسرب من بين يدي هو الذي يمدني بالطاقة، لا أريد تأجيل أي مشروع”
المترجم والروائي والشاعر والباحث جان دوست.. الذي يسرد في كل مشروع إبداعي له، حكاية الكردي-الإنسان.
كل مأساة تُخلق لديه فكرة يسردها على شكل قصة، رواية أو قصيدة..عن الكتابة والسرد الروائي ومحاور أُخرٍ يجيب مشكوراً …
م.س_ الرواية السياسية “Roman politique” ذات المنحى السياسي والتي تنزع نحو نوع من الواقعية القرارية ولا تتميز عن غيرها من الروايات إلا بتأكيدها على الحدث السياسي…
والسؤال: الروائي جان دوست تمكن من إنجاز الرواية السياسية، ما هي الصعوبات التي من شأنها أن تزدحم على مؤلفها حدثاً وكتابة وموضوعاً، لاسيما أنّ كاتبها يقدّم فيها رؤيته السياسية كقضية من قضايا الواقع؟
ج. د: كل رواية سياسية متهمة بالانحياز. لأنها رواية موقف. رواية إدانة. وهي رواية انحياز فعلاً. انحياز إلى قضيةٍ ما. وهناك صعوبات كثيرة تقف في طريق الروائي الذي ينخرط في كتابة رواية سياسية، أولها الخلط النابع عن الجهل أو المتعمّد من قبل جهات سياسية معينة بين الموقف الإنساني وبين السياسة ثم إدانة القتل مثلاً موقف إنساني بل هو واجب قبل أن يكون موقفاً. فعلتُ ذلك في رواية “دمٌ على المئذنة” و “ممر آمن” و “كوباني” و”إنهم ينتظرون الفجر “و “باص أخضر”. ولعلك تلاحظين أنّ هذه الروايات تتمحور حول زمن يعيش فيه الكاتب ويكتوي بلظى أحداثه الساخنة. لا يمكن أن تُكتب روايات كهذه تتناول أحداثاً معاصرة وقضايا جوهرية إلا بنفس سياسي. ولأكن أكثر دقة: لا يمكن أن تُكتب إلا بنفس إنساني يدين القتل ويفضح القتلة بدل أن يغطي على جرائمهم أو على الأقل يسكت عنها كما فعل بعضهم.
م.س_ الفلسفة كنسق فكري يعنى به أهل الاختصاص دون غيرهم. اليوم تعيش الرواية عصرها الذهبي، تطرح أموراً فكرية وأيديولوجية وسياسية وعلمية ونفسية، فهي بذلك تحمل رؤية إلى القارئ إلى جانب دورها الفني والإقناعي. هل اعتمد جان دوست الكردي الرواية معلماً لنشر أفكاره وفلسفته الوجودية؟ كيف لها الرواية أن تنقل الفكر الفلسفي وتعزز الوعي التنويري؟ لا سيما بين القرّاء غير الملمين بالوجود الكردي…!
ج.د: الرواية إحدى تجليات الفلسفة. وليست هناك رواية بدون فلسفتها الخاصة. بدون نظرتها إلى التاريخ والمجتمع والحياة. الفرق أنّ الفلسفة كعلم أو نسق فكري كما ورد في متن السؤال فيها بعض الجفاف الذي يمنع استساغتها من قبل جمهور القراء العاديين. يأتي الروائي بأدواته المؤثرة ليبسط فلسفته على لسان شخوصه ومن خلال سرد الوقائع ببساطة. أحياناً تكون بعض الروايات كشرح أو تفسير لقضايا فلسفية لا يمكن فهمها إلا من خلال الرواية. وأعتقد أنّ لكل رواية فضاؤها الفلسفي الخاص بها. كتبت عشيق المترجم ونواقيس روما عن فكرة التسامح وقبول الآخر واكتساب الهويات الهجينة التي تخفف من مشاعر الكراهية. كتبت مارتين السعيد أو الألماني السعيد عن فكرة السعادة والبحث العبثي عنها. في ميرنامه عالجتُ موضوع المثقف والسلطة. ليست لدي فلسفة حياة معينة. إنّما مجموعة أفكار أبثها على ألسنة أبطال رواياتي ومن خلال أحداث معينة. يهمني بدرجة أولى أن أعالج فلسفة التاريخ، والتاريخ الكردي بشكل خاص، أحاول تفكيكه والبحث فيه عما يروي ظمأي إلى الحقيقة.
“يهمني بدرجة أولى أن أعالج فلسفة التاريخ، والتاريخ الكردي بشكل خاص، أحاول تفكيكه والبحث فيه عما يروي ظمأي إلى الحقيقة”
م.س_ ناضجة، مختمرة ومكتنزة لغة السرد لدى الروائي جان دوست… عن تطور اللغة في السرد الروائي: اللغة قد تمر بذات المراحل العضوية فيزيائياً إن شئنا توصيفها، ولادة وطفولة ومراهقة واختمار.. كيف تصف لغة السرد لدى جان دوست في تطورها الشخصي؟ ماذا تخبرنا عن تحولات الفعل السردي من الرواية الأولى إلى الأخيرة مروراً بالباقيات؟
ج.د: لغة السرد تتطور وتنضج مع مرور الزمن. وقد يكون العكس فيخبو بريقها وتتجه للضعف. والمختبر السردي لدى هذا الروائي يختلف عن مختبر السرد لدى ذاك. شخصياً تنوع السرد عندي بحسب المادة أو الموضوع الذي تناولته. السرد في روايتي الأولى كان صاخباً. سريعاً. بكائياً مقطوع الأنفاس. في ميرنامه كان متزناً متناسباً مع الشخصيات الـ 21 الني تناوبت على السرد. في نواقيس روما وسابقتها عشيق المترجم كان بطيئاً رتيباً أقرب إلى التأملات الفلسفية. في دم على المئذنة السرد غاضب. في ممر آمن كذلك مع ميل واضح إلى البذاءة التي تناسب بشاعة الحرب. في كوباني السرد رثائي بكائي مختلف الإيقاعات. وهكذا. أعتقد أنني استفدت من تجاربي ومن ملاحظات القراء والنقاد كثيراً فطورت أساليبي السردية في الروايات الأخيرة.

م.س_ ممر آمن إلى عفرين مأساة مدينة كردية لا تزال محتلة.. الكاتب كردي، الشخوص بأسماء كردية.! ممر آمن عنوانٌ دال على الهدوء، إلا أنّ واقع النص الروائي استبعد دلالة الأمان، الممر الآمن ما كان إلا نصلاً في خاصرة عفرين وما نتج عنه من تغيير ديموغرافي فيها… برأيك هل يمنح العنوان فلسفة وعلائقية لـ/بالسرد الروائي؟
ج.د: تكون العناوين في بعض الروايات زعزعة لليقينيات. عتبة أولية للسخرية من الواقع. وأنا اخترت عنوان ممر آمن لأتحدث عن نقيض الأمن والأمان. لأسخر من ادعاءات مشعلي الحروب بأنهم إنسانيون. الحرب تنتج مفاهيمها الخاصة. ممر آمن مصطلح في قواميس الحروب المعاصرة يُقصد منه ظاهرياً عمل إنساني لإنقاذ المدنيين من ويلات المعارك. لكن في الحقيقة هو طريق للتهجير القسري. طريق لطرد الآمنين وتشريدهم من بيوتهم بعد إشعال نار الحرب. ما الحاجة لممر آمن في مدينة أو منطقة كانت آمنة أصلاً؟ وهذا ما يرد على لسان الطفل كاميران الذي يدرك بوعيه الطفولي الذي أنضجته الحرب أنّ الممر الآمن ليس سوى كذبة.
“نمرُّ على ثوراتنا إما بعيون الانبهار أو بعيون الرثاء. لا شيء بعد ذلك”
م.س_ ” ميرنامه، كوباني، مهاباد.. ثلاث خطوات إلى المشنقة..” وفي غيرها من الروايات يحاول جان دوست على الدوام إسقاط الحالة الكردية وتأريخ الحدث الكردي.. في أعمالك توثق الحدث التاريخي كما المعاصر والمسافات الزمكانية بينكما شاسعة جداً. كيف للروائي جان دوست أن يقف على تلك الأطلال بمخياله؟! وكم عليه أن يقع في شرك الموت ليُنهِض ذلك الحدث من رقاده؟
ج.د: يتحول التاريخ إلى جثة متحللة إن لم ننبش في طياته عن “أنانا” القديمة التي مهدت لـ”أنانا” الحالية بالتشكل. مشكلة الكرد كما أردّد دائماً أنهم لا يقرأون تاريخهم. وعندما أقول لا يقرأون لا أعني فعل القراءة. فالكتب التاريخية متوفرة وهناك إقبال عليها حتى من قبل القراء متوسطي الثقافة. ما أعنيه في هذا السياق هو القراءة النقدية. السبر في الأعماق والحفر داخل الطبقات التي شكلت هويتنا الحالية وبالتالي هذا المصير المفجع الذي تعيشه الأمة الكردية بملايينها الخمسين دون دولة، دون كيان ودون تأثير. التاريخ في كردستان يتكرر بشكل رهيب. النكبات تتكرر وكأن القدر يستنسخ منها كل بضعة أعوام نسخة طيق الأصل. لماذا؟ لأن تشريح التاريخ ونقده لم يبدأ عند الكرد. المؤرخون الكرد منذ شرفخان لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد. لم يحدث عندنا تراكم في الحقل التأريخي حتى يمكن الاستفادة منه لاحقاً. نمر على ثوراتنا إما بعيون الانبهار أو بعيون الرثاء. لا شيء بعد ذلك. أنا أعود للتاريخ لأعيد تشكيله وأرسم صورته الحقيقية بعيداً عن “العنتريات” والزهو الباطل. لا يهمني التاريخ المجيد بقدر ما تهمني “كبوات الجواد الكردي”. وعملي في مجال الرواية التاريخية هو إسقاط كما في توصيفك. لأن الحاضر لا يختلف عن الماضي. وهذه معضلة أن يسير تاريخنا في خط دائري بعكس حركة التاريخ الطبيعية السائرة إلى الأمام. عندما أكتب في مخطوط بطرسبورغ عن محنة المثقف الكردي اللامع ملا محمود بايزيدي وأنّ أمراء الكرد لم يلتفتوا إلى معرفته الموسوعية وأنّ قنصلاً أجنبياً اكتشف ذلك واستفاد منه فأنا أتحدث عن واقعنا الآن وليس عن عام 1850. أود أن أقول (وهذه إحدى رسائل الرواية): انظروا يا قوم ما الذي اختلف في حكامكم وفي واقعكم وفيكم أنتم بعد 175 عاماً؟ في مجنون سلمى التي خصصتها لحياة أكبر شعراء الكرد على الإطلاق وهو ملايى جزيري أبين أنّ الصراعات الكردية البينية والتنافس على الزعامات ليست وليدة اليوم بسبب الانقسامات الحزبية. بل هي جزء من تركيبتنا المتوارثة. وستبقى كذلك ما لم يتم تشريح التاريخ وتفكيكه والبحث في طياته (أكرر) عن الأسباب التي رسخت هذا الثبات البغيض.
م.س_ يعيش الكرد في مجتمعات غير متجانسة لا جغرافياً ولا فكرياً، الرواية الكردية المطروحة باللسان العربي لأي مدى كانت قادرة أن تجمع شتاته؟ هل تمكنت من تقريب المسافة بينهم؟
جان دوست الكردي، شاعر وباحث ومفكر يكتب بالعربية.. ما أكبرالتحديات التي يمكن أن يواجهها؟ سواء من حيث فكرة التنقل بين لغتين أو الأحكام التي تصدر من القارئ الكردي؟
ج.د: الرواية الكردية المكتوبة بالعربية ليست بقادرة على جمع شتات الكرد. ربما تمكنت هذه الرواية أن تضيء زوايا من التاريخ الكردي للقراء العرب، واستطاعت أن تكشف المجتمعات الكردية، وتلقي بعض الضوء على حياة الجيران الذين همشهم الإعلام العربي قبل أن يعودوا إلى الظهور بقوة بعد محاربة داعش.
أنتقل للشق الثاني من سؤالك فأجيب: التحديات التي أواجهها كبيرة حقاً. من المفروض أن يحتفي بنا الإعلام العربي والأوساط العربية بشكل أكبر. فنحن الكرد الذين نكتب بالعربية نساهم في تعزيز اللغة العربية وتطوير الرواية العربية. نحن جزء من ظاهرة كبيرة هي العربفونية ومن حقنا أن نعثر على المكان اللائق بمنجزنا الروائي. دار نشر مغربية رفضت نشر بعض أعمالي بحجة أن القارئ المغربي ربما لن يهتم برواية تتحدث عن الكرد!! وهذا غريب. ما دور الرواية إن لم تساعدنا معرفياً وتفتح نوافذ على الآخرين؟ العالم كله احتفى بعدّاء الطائرة الورقية لأنه يكشف ما كان يجري في أفغانستان. فلماذا لن يهتم قارئ من المغرب أو من الإمارات أو السودان بما يجري في كردستان؟ على النقيض من ناشرنا المغربي، هناك ناشر سوداني تبنى نشر كل أعمالي في طبعة سودانية خاصة. وهذا هو المطلوب.
أمّا الكرد فينظر بعضهم للأسف بعيون الريبة والاستنكار إلى الكرد الذين يكتبون بالعربية. يعتبرونهم خونة ومستعربين.
” الشعر الآن عندي يشبه الوخز الذي نشعر به في الخاصرة أحياناً. لا بد أن أتأوه. لكن الرواية تستهويني. تناسب ما وصلت إليه من سن وخبرة في الحياة والقراءات.
م.س_ “العلاقة بين الرواية والسياسة طبيعية منطقية لأن كل منهما الرواية والسياسة تهتمان بحياة الإنسان”.. هل من شأن الرواية أن تهذب السياسة وتعيد أي مغالطة تاريخية إلى مسارها الصحيح؟ أو لنقل كيف لها أن تهذب الإنسان؟ لو اعتبرنا على سبيل التمثيل في رواية كوباني شخصية الراعي التونسي زياد، أنها إشارة إلى إنقاذ الضحية التي تقع في فخ الخطاب الديني الإرهابي؟!
ج.د: لا نريد تحميل الروايات كجنس أدبي ما لا يمكن لها أن تتحمله أو تحمله. الرواية إبداع أدبي شامل ومتعدد الأوجه. ولكل رواية رسالتها أو رسائلها الخاصة. في النتيجة الرواية إسهام في حقل المعرفة يرتقي بذائقة الإنسان ويوسع آفاقه الفكرية وأستطيع القول: أنها قادرة أيضاً على تغييره نحو الأفضل. بالنسبة لزياد التونسي، وهو أحد شخصيات روايتي كوباني، فهو يمثل الجيل التائه الذي يقع فريسة التنظيمات الإسلاموية. إنها شخصية مركبة يحولها التهميش والفقر والظلم من ضحية إلى جلاد.
م.س_ “المكان المعضلة”
“كتبتُ رواية كوباني بدافع توثيقي، أن أوثق خراب مدينتي ثم أوثق المقاومة التي حدثت فيها كنوع من التعويض، أنا لم أذهب إلى المدينة في الرواية؛ أتخيل أني عدت إليها لكن عدت إلى أنقاض وبيوت مدمرة”
في السعي لمنح السؤال منحىً أوسع، كيف للكوارث أن تتحول إلى نصّ أدبي؟ أي أسلوبٍ للمؤلف يمكّنه من ترويض خياله في توثيق أزمة أو حدث أو مأساة؟
هل يمكن المزج في هذه الحال بين النصين التاريخي والفني تحت تأثير الخيال والواقع؟
ج.د: هذا يعتمد على أسلوب الكاتب وامتلاكه أدوات التعبير المناسبة. المآسي بشكل عام تتقولب أدبياً في شكل مسرحية، شعر سينما ورواية إلخ.. الأمر يرتبط بقدرة المبدع على تحقيق معادلة الإبداع: الواقع زائداً الخيال يساوي الإبداع.
لن أحكي عن كوباني، مدينتي المغدورة، أكثر مما حكيت في حواراتي السابقة. أتألم في كل مرة كأن الجرح لا يريد أن يلتئم.
م.س_ ” أدبٌ لا يتفلسف وفلسفة لا تتأدب يبقيان بدون بقاء، لأن كلاً منهما واجب وجودٍ للآخر”
فلسفة الخيال في القصة والرواية والشعر، لأي مدى تخدم هذه الفلسفة، السرديةَ للخيال بآلياتها، الأدب والفن والحياة؟
ج.د: الخيال من مداميك الرواية.
والخيال هو هذه القدرة العالية على الخلق. صناعة الطائرة سبقها خيال رسم هيكل الطائرة في ذهن المخترع. وقيسي على ذلك كل شيء. المدن الكبرى التي نراها، الجسور، الصناعات، كلها وجدت أولاً في الخيال. ونحن أيضاً وهذا الكون اللانهائي وجد قبل أن يوجد في خيال موجد عظيم. ألا يقول القرآن: وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة؟ قبل وجود الخليفة الذي هو الإنسان كان لدى الخالق تصور كامل عنه. وقد خلق الله الإنسان (على صورته) كما يقال.
“على العموم أغبط نفسي لأن نصوصي نالت بعض الحظوة من كتاب ونقاد ليس شأنهم قليلاً.”
م.س_ ثمّة روائيين رفضوا التزامهم بنقل رسالةٍ ما. برأيك هل ينجح الروائي دون أن يتضمن نصه الهمّ الإنساني المتناسب طرداً مع مدى امتلاكه لأدوات السرد المعرفية؟ هذه الأدوات بالنهاية حصيلة التجارب البشرية.
ج.د: نجاح الرواية غير مرتبط بالرسالة التي يحملها. قد تكون هناك رواية ذات رسالة عظيمة، لكنها فقيرة البنية، هشة الخيال، ضعيفة اللغة. وعلى كل حال فتحميل الرواياتِ رسائلَ معينة من ترجيحات الكتاب وليس إلزامياً البتة.
م.س_ “الشعر لم ينقل همي كما أريد، فلجأت إلى كتابة الرواية..” ايهما انتصر جان الروائي أم جان الشاعر؟ أيها تحنو على يدك أكثر الرواية أم القصيدة؟
ج.د: الشعر قصير النفس. لهاث متسارع، برق يلمع، يخطف القلوب، العاطفة تشعل ناره والعقل يتنحى في كثير من الأحيان. أما الرواية فعميقة، هادئة، عمل دقيق، بحث وتقصٍّ ودراسة متأنية. الروائي باحثٌ في الأفكار وشاعرٌ في اللغة وبما أنني اشتغلت في البحث وكتبت الشعر، فقد استفدت كثيراً. الشعر الآن عندي يشبه الوخز الذي نشعر به في الخاصرة أحياناً. لا بد أن أتأوه. لكن الرواية تستهويني. تناسب ما وصلت إليه من سن وخبرة في الحياة والقراءات.
م.س_ في المقاربات النقدية التي تم فيها تحليل ديناميات التشكيل الروائي في مفاصل تجبّرت الروائي دوست، هل كان اجتهادها” المقاربات” كافياً في استيعاب طاقة الفلسفة السردية في رواياتك؟ هل أنصف النقد الروائي جان دوست؟ وهل يتم نقد نصك الأدبي بالمحايثة بعيداً عنك؟
ج.د: المتعة التي تمنحني الرواية حين التفكير فيها وخلال كتابتها وبعد الانتهاء منها تغنيني. هذا لا يعني أنني لا أفرح بنقد ينصفني ويتناول رواياتي. أمر طبيعي أن أشعر بالرضا من مقال يحلل رواياتي أو بحث أستفيد منه لمتابعة مسيرتي الروائية. للأسف النقد يتناول ما اشتهر من الروايات. ما من ناقد يكتشف نصاً ويخبرنا عنه. هذه وظيفة النقد الأساسية. ودعيني أستعيض عن النقد مصطلح البحث الأدبي، فالنقد دلالة سلبية في الأذهان من كثرة من يتسلقون جدران النقد ومن دأبهم الطعن في الخصوم الأدبيين وتصفية الحسابات والترصد واستقصاء الأخطاء. هذا هجاء وليس نقداً. لقد التبس مفهوم النقد بسبب وجود طفيليات نقدية في ساحة الأدب.
على العموم أغبط نفسي لأن نصوصي نالت بعض الحظوة من كتاب ونقاد ليس شأنهم قليلاً.

م.س_ عملية خلق الفعل الروائي، الفكرة الأولى.. كيف تتشكل لديك الكلمة أو العبارة الأولى والأخيرة؟
هل يمكن اعتبار أعمال جان دوست الروائية أعمالاً مهيكلة مبنية على البداية والنهاية؟ هل تريد منها “الرواية” عملاً مكتملاً؟
أم تترك فجوة قد تنبثق منها خلال العمل عليها فكرة تلمح إلى المجهول، الغيب، ولادة عمل جديد؟!
ج.د: في أي عمل أدبي لا بد من شرارة. بعض الشرارات تتحول إلى نار عظيمة وبعضها تضيع دون أن تشعل ناراً. بعد الشرارة الأولى أو الـ Big Bang الروائي تأتي الدراسة والبحث وجمع الأفكار والتخطيط والمثابرة على رسم السراديب والمداخل والمخارج اللازمة. شخصياً الإعداد للرواية يستغرق عندي وقتاً طويلاً. كتابتها لا تتعدى أحياناً بضعة أشهر أو أسابيع. كتبت اللاهي-فردوس الكاتب العجوز في ثلاثة أسابيع! كانت الرواية كلها في عقلي. احتجت فقط إلى بعض الوقت للتدوين.
رواياتي كلها مرتبطة عبر شخصيات أو أحداث معينة. تجدين في الأسير الفرنسي شخصية من عشيق المترجم ونواقيس روما. في نواقيس روما تجدين شخصية قادمة من مارتين السعيد. في مارتين السعيد، البطل يكون موجوداً في ميرنامه بشكا ضبابي. وهكذا. هذه وحدها تلزمها دراسة أو بحث خاص.
م.س_ “الروائيون العظام هم الروائيون الفلاسفة، أي أضاد كتّاب البحوث قبل بلزاك وبروست وكافكا.. هذا ما صرح به آلبير كامو في كتابه أسطورة سيزيف. هل كان كامو قريباً إلى الصواب في تصريحه هذا؟
ج.د: لأن كامو فيلسوف فهو يقول هذا الكلام. وهو محق في ذلك طبعاً. هذا ما أسميه العمق في الرواية. رواية بدون عمق، بدون نظرة خاصة إلى الموضوع المطروح، تكون ناقصة. مع التشديد على أن الانخراط في الفلسفة ليس شرطاً لنجاح الرواية. بل قد يكون ذلك عبئاً. أساطير مثل سيزيف، جلجامش، نرسيس، وغيرها تحمل بعداً فلسفياً واضحاً وتثير أسئلة وجودية انشغل الإنسان بالبحث عن أجوبتها لآلاف السنين. هذا جانب من جوانب الرواية.
م.س_ عن جدلية العلاقة وتعقيدها بين النص الأدبي ومؤلفه من جهة والنص والقارئ من جهة ثانية. جان دوست، هل يمنح القارئ مسافة تجعله يملأ الثغرات ويقيم النص وفق تصوره الخاص؟ حاول منح الاستحقاق في السعي إلى إقحام المتلقي في عمله الروائي؛ ليكون شريكه في العملية الإبداعية؟ في الرواية التاريخية التي تقدمها، سلطتك الأقوى أم سلطة القارئ؟ هل تمنحه الحق في ترديد وتكرار” لماذا؟! النقاقة” الخاصة بكمال الحاج؟!
ج.د:العلاقة بيني وبين القارئ على العموم جيدة. أحترم سلطته وثقافته. أحاول أن أقدم له مادة ممتعة. هناك قارئ ينتظرني وأحسب حسابه. في كل سطر من الرواية أتخيل لحظة التلقي. كيف سيكون وقفه هذه الجملة عنده؟ ماذا ستكون ردة فعله حين يقرأ هذه الفكرة؟ أحترم القارئ لكنني لا أجعله رقيباً. دور النشر أحياناً تتدخل وتقول: هذه الفكرة جريئة أكثر من اللازم. إنها تكسر التابو. هذا المشهد موغل في الجنس. هذه العبارة صادمة إلخ. لكنني على يقين من أن القراء أكثر انفتاحاً وجرأة من دور النشر. القارئ أكثر تسامحاً من الناشرين. للأسف دور النشر أحياناً تتوهم قراء متسلطين عنيفين ومتشددين في الدين والأخلاق. وهذا الأمر ينبغي تجاوزه.
السيرة الذاتية للكاتب:
- جان دوست/Jan Dost ولد في كوباني_حلب عام 1966
- درس العلوم الطبيعية في جامعة حلب. هاجر عام 2000 إلى المانيا وحصل على جنسيتها.
- كتب الشعر منذ سن الطفولة,له أربعة دواوين شعرية.
- عمل في الصحافة منذ عام 1986 كاتباً ومحرراً.
- ترجم عدداً من الكتب وأصدرها باللغتين العربية والكردية. إلى جانب ذلك أصدر إلى الآن ست عشرة رواية تُرجم بعضها إلى الإيطالية والإسبانية والفارسية والتركية.
- حاز العديد من الجوائز منها جائزة جكرخوين CEGERXWIN في مهرجان الشعر الكردي بمدينة إيسن 2012.
- عمل في الترجمة لدى BAMF ومراكز إيواء اللاجئين في ألمانيا.
- رئيس تحرير مجلة كوردستان بالعربي الشهرية الصادرة في أربيل.