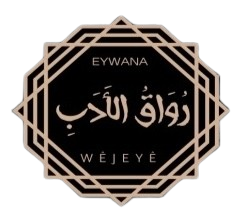فادي أبو ديب/ السويد

ككثير مما يتعلق بمفهوم الهويّة تبدو مسألة نسب الأدب إلى شعب أو ثقافة معينة قضية غير مغلقة ولا يمكن البتّ فيها بشكل فوريّ. وكون القضية “غير مغلقة” لا يعني أنها “مفتوحة” تماماً، ولكنها تتعلّق بعدة عوامل تاريخية وسياقية معينة تختلف من مكان إلى آخر وتختلف بين زمان وزمان. ولهذا فالنقاش الآتي لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى حيّز القناعات النهائية المعتمدة على معطيات مخبرية حاسمة.
الأدب كما أتصوّره بشكل أوّليّ هو جسم لغويّ ثقافيّ يعبّر بوسائل فرديّة أو جماعيّة عن مكوّنات فردية أو جماعية لمجموعة بشرية معينة مرتبطة فيما بينها بروابط معيّنة ليست محددة بشكل نهائيّ. وهو أيضاً على علاقة وطيدة بالمؤسسات التي تستقبله وتؤرشفه وتحفظه وتدعم وجوده والبحث فيه، وبالثقافة الشعبية التي تأخذ موقفاً منه وتتفاعل معه، وتختزنه وتعيد إنتاجه أو تحاربه وما إلى ذلك. والأدب بطبيعته فعل مثاقفة، وفي المثاقفة تتفاعل الهويات بما يتيح خيارات جديدة تظهر على مسرح التاريخ. ولذلك فسؤال نسبة الأدب الكُرديّ المكتوب باللغة العربية إلى الأدبين العربيّ والكرديّ هو أحد هذه الأسئلة غير المغلقة، لأنها ببساطة لا يمكن برأينا طرحها
بصورة عامة، بل يمكن أن يُطرَح هذا السؤال حول أدب كلّ أديب كُرديّ (أو غيره) يكتب باللغة العربية أو العكس، لأنّ الإجابة ينبغي أن تكون ممثلة أفضل تمثيل لفعل المثاقفة الذي يتيحه الإنتاج الخاصّ بأديب أو أديبة بشكل خاصّ وفريد من نوعه.
وعلى هذا يمكن النظر إلى سؤال فيما إذا كان الأدب الذي ينتجه أديب كرديّ باللغة العربية منتمياً إلى الأدب الكرديّ من زاويتين ليستا نافيتين لبعضهما البعض بل متكاملتين.
(1)
وفي التاريخ العربي-الإسلامي يبرز هذا الفعل التثاقفي واضحاً في أعمال كثيرة من أهمها “كليلة ودمنة” و”ألف ليلة وليلة”. ولا يشكّ دارس مطّلع على تاريخ الأدب بنسبة هذين العملين للتراث العربي ولكونهما يشكلان جزءاً كلاسيكياً وأصيلاً من التراث العربي. وذلك على الرغم من كون أولهما عمل هنديّ تُرجِم إلى العربية عن نسخة فارسية، وثانيهما مؤلّفاً من عشرات الحكايات والقصص التي تمت الإضافة إليها والتعديل عليها عبر العصور، موجودة كلها في قصة إطارية كُبرى يبدو واضحاً من جميع تفاصيلها أنها تنتمي إلى العالم الفارسي بأجوائه وأسمائه مثل “شهريار” و”شهرزاد” و”دنيازاد”. ولكن ما جعل هذين الكتابين ينتميان إلى الأدب العربي ليس وجود الدولة أو الدويلات الإسلامية التي سادت عبر القرون فحسب، وليس لأن لغة الدين والدولة كانت العربية فقط، بل أيضاً لأنّه تمّ تبنّي روح هذين العملين من قبل التراث العربي الشعبي، وأصبحا جزءاً لا يتجزأ من الروح القصصية والمخيال الشعبي الذي تفاعل معهما وأرشفهما في مخازنه الثقافية وأضاف وعدّل وأعاد إصدار هذه الأعمال بشكل متكرر عبر العصور، كما نسج على منوالهما بأشكال لا تحصى ولا يمكن أن تندثر، شفهياً وكتابياً. وينطبق عين الأمر مثلاً على شخصية “جحا” وقصصه وأحاجيه وطرائفه. وكما ذكرنا أعلاه، فالقضية ليست مفتوحة تماماً ولكنها ليست مغلقة، بمعنى أنه لا يمكن لكتاب كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة أن يكون جزءاً من التراث الياباني أو الروسيّ أو تراث التيبت، لأن الشروط الأولية، السياسية والاجتماعية والدينية واللغوية، التي تجمع هذه الأعمال إلى تلك الثقافات ليست موجودة، حتى لو تمت ترجمة هذه الأعمال وتدريس يعض منها في المدارس اليوم على سبيل المثال، ولكنها أيضاً ليست مغلقة ومحسومة بمعنى أنّه لم يكن من الحتميّ أن تصير هذه الأعمال الهندية والفارسية (جزئياً) جزءاً لا يتجزأ من الأدب العربيّ والمخيال التراثي العربيّ، فعناصر الاندماج تبقى شديدة التعقيد ويجب دراستها ومتابعتها بتفصيل وحرص. كان يمكن لكتاب كليلة أو دمنة أن يترجم إلى العربية بأمر أميرٍ أو والٍ ثم يختفي مع مرور الوقت. ولكن هذا لم يحدث لأنّ العمل صار ذا معنى للذهنية الناطقة باللغة العربية، إن صح التعبير بهذه الطريقة.
ولعلّ للمدة الزمنية أيضاً دور في الأمر؛ فرباعيات الخيام مثلاً لم تصبح جزءاً من التراث العربي ربما لأن كاتبها، عمر الخيّام، كتبها بالفارسية في زمن انحطاط السيطرة العربية على الامتداد الإسلامي ولأنها لم تترجَم في ذلك الزمن لتصير جزءاً من ثقافة المجتمعات الناطقة بالعربية، بل حديثاً—هذا على الرغم من أنها انتشرت بعد ترجمتها وغنّت أمّ كلثوم منها وشاعت بين عدد كبير من المثقفين العرب خلال القرن العشرين. ولعلّ لقِدَم الترجمة وطريقة الاتصال والتواصل دور كبير في عمق تفاعلها مع الأوساط اللغوية الأجنبية عنها. هذان أيضاً أمران يلعبان دوراً هاماً في انغراس تراث لغويّ معيّن في تراث آخر وإمكانية تحوله إلى جزء عضويّ من ذلك التراث.
الأدب بطبيعته فعل مثاقفة، وفي المثاقفة تتفاعل الهويات بما يتيح خيارات جديدة تظهر على مسرح التاريخ.
وعلى نفس المنوال، ولو أنّ المقارنة جزئية وليست شاملة لأنه لا يوجد تطابق شامل بين الحالتين، يمكن تناول الأدبين العربي والكردي حين يكون الأديب منتمياً إثنياً إلى الشعب الكُرديّ ويتكلم اللغتين العربية والكردية، أو العربية فقط؛ فالرواية التي يكتبها أديب كرديّ أو أديبة كرديّة تنتمي بطبيعة الحال إلى الأدب العربي حين تكون مكتوبة بالعربية، لأنّ الشرط الأولي المضمر فيها، والمتعلق بالجمهور، هو جمهور ناطق باللغة العربية، بغض النظر عن مرجعيته الإثنية، حتى لو كان سياق الأحداث في الرواية يركّز بصورة محورية على بيئة كردية. الأمر نفسه يمكن أن نراه عند إبراهيم الكوني؛ فرواياته وقصصه القصيرة جزء أصيل من الأدب العربي، رغم أن معظمها (إن لم تكن كلّها) تدور في بيئة أمازيغية طوارقية، وتحتوي على الكثير من المفردات والعبارات الأمازيغية. ولكنها مع ذلك يمكنها أن تُدرَس فوراً وبدون مقدمات كجزء من السرد العربي الحديث، لأنها تساهم فعلاً في إغناء هذا السرد وتراكيب لغته ومفرداتها ومحتواه الفلسفي وعلاقته مع الآخر والشقيق التاريخيّ والثقافيّ والجغرافيّ. ولكن يمكننا هنا أن نقترح، وهذا اقتراح أوّليّ كنقطة انطلاق للحوار لا أكثر، أن انتماء أدب الأدباء الكرد المكتوب بالعربية (وأحياناً بعربية عالية وفريدة جداً) إلى الأدب الكرديّ، يتطلب فاعلية ومبادرة من المجتمع الكردي، المعاصر أو اللاحق لهم. الأمر هنا كما أشرنا سابقاً غير مغلق وغير حتميّ، ولا يمكن البتّ به مسبقاً كما لو كان ضرورة تاريخية؛ فإذا تمّ تبنّي هذا الأدب (ويمكننا أن نتناقش مطولاً حول مفردات ومعنى هذا التبنّي) في المجتمع الكرديّ (أو الأمازيغي في حالة الكوني) وأصبح جزءاً عضوياً من الجسم الأدبي، رسمياً في المدارس مثلاً والإعلام والجامعات والبحث الأدبي، وشعبياً ضمن حدود معينة تتعلق على الأقل بالمثقفين العموميين والقرّاء، وأصبحا رمزاً من رموز روحانية المجتمع الجديدة، فسيكونان بكل تأكيد جزءاً لا يتجزأ من “الأدب”. فهذا الأدب لا يمكنه أن يساهم بطريقة مباشرة في اللغة الكردية، بنفس طريقة مساهمته بلغته الأمّ (العربية في هذه الحالة)، وهو أجنبيّ بالنسبة لمن لا يستطيعون القراءة باللغة العربية. ولكنه في حال كونه يعبّر عن الثقافة الكردية كبيئة وشخصيات وهموم وآمال ورمزيات—وهذا أمر كما أشرنا سابقاً يبقى خاصاً بكلّ كاتب على حدة— فإنّه هنا يبقى منتظراً إيماءة الاستقبال من المجتمع العميق الذي يمثّله، أي أن يشعر الكرد أنفسهم بأنّ هذا الأدب ينتمي إليهم ويمثّلهم روحياً ورمزياً. في حين أنّ هذا الأدب نفسه، الذي كتبه الكرد باللغة العربية، لا يحتاج إلى اعتراف ليكون جزءاً من الأدب العربيّ؛ فهو ككيان لغوي-ثقافي يعبّر عن ذاكرة لغوية وتاريخية وبنيان لغويّ عميق الجذور الثقافية ساهم في تشكيله منذ البداية مجتمع متعدد الهويات والمرجعيات، وهو أدب عربيّ حتى لو حاربه كل الناطقين بالعربية.
(2)
ومن ناحية أخرى، ولأنّ الهويّات ليست قوالب جامدة، فربّما، ولعله الأقرب للصواب القول إنّنا لا نقف هنا أمام حالة إمّا-أو، وليس بالضرورة أن يكون الأدب إما عربياً أو كردياً، وليس بالضرورة أن يكون العمل أصلاً عربياً خالصاً أو كردياً خالصاً، من الناحية الرمزية والثقافية؛ فيمكن له أن يكون عربياً-كردياً أو كردياً-عربياً (العروبة هنا لا تشير إلى أي دلالة إثنية) أو يمكن أن يكون كردياً-سورياً أو كردياً-عراقياً أو تركياً أو في بعض الأحيان قد ينجح في تجاوز بعض الحدود، وهذا يعتمد كما أشرنا أعلاه على كل خاصة بمفردها. ولعل من الأدقّ في الحالة السورية على سبيل المثال، نحت مصطلح مثل “كردو-سوريّ”، يعبّر عن أدب عربيّ اللغة ذي خصوصية من حيث تمثيله للمجتمع الكرديّ في سوريا، وقد يتجاوزها، ويشبه في ذلك الأدب الأمريكيّ الذي كتبه أشخاص يتحدّرون من مجتمع ناطق بالعربية، فهو أدب أمريكيّ خالص، إنكليزيّ اللغة، وإن كان يعبّر أيضاً عن رمزية وثقافة عربية، حيث يعود الأمر هنا للعرب أن يجعلوه جزءاً من الأدب العربي. والمجتمع الكرديّ، كأي مجتمع واسع الانتشار في العالم، فيه من يتكلم اللغة العربية كلغة أولى، وفيه من يتكلمها كلغة ثانية، وفيه من يقف من اللغة العربية موقف الأجنبيّ أو شبه الأجنبيّ عنها، وفيه من لا يتكلّم الكرديّة. وعلى هذا فسيكون الأدب المكتوب بالعربية بالنسبة للناطق بالكردية مختلفاً عمّا هو عليه بالنسبة لغير الناطق بها. ولا ينبغي أن ننسى هنا أنّ وسم الأدب بصفة معينة هو أيضاً فعل سياسيّ يعتمد على كيفية تشكيل الهوية الشاملة والهويات الفرعية ومأسستها رسمياً والعمل على تأمين استمراريتها الفاعلة في التاريخ، بالإضافة إلى كونه فعل تفاعل رمزيّ مع الجماعة البشرية وأعماقها التخييلية والروحية والرمزية، ولذلك فهذا السؤال، ومع وجود محدّدات معينة لا يمكن تجاوزها عند محاولة الإجابة عليها، يبقى غير مغلق على شكل واحد من أشكال الإجابات الإيديولوجية.
فادي أبو ديب: شاعر وكاتب وباحث سوريّ، يتخصّص في الدكتوراه بالفلسفة الدينية الروسية عند فلاديمير سولوفيوف ونيكولاي برديايف. لديه عدد من المجموعات الشعرية، آخرها مجموعة قيد النشر بعنوان “الضوء الغامض الصوت: الظهور الوشيك للكائنات الشفافة”. مقيم في السويد حيث يعمل في جامعة دالارنا.