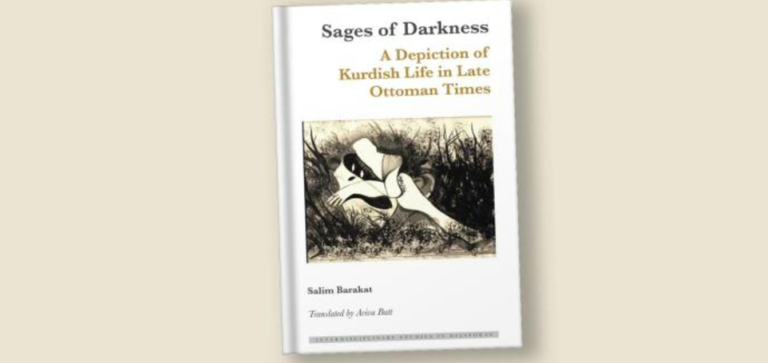تفعلُ اللغات كما تفعل الديناميت، أو عكس هذه العبارة في نسق تاريخيّ معاصر بالضرورة، فالعلاقة بينهما علاقة مضطربة، تكاد أن تكون في حيّز واحد، وهو الموت، الموت بالكلمات، والدفن بها، والطمس بها.
الخطاب الديني، من أبرز ما ترك لنا من الحراك والجلجلة داخل المجتمعات، بدءاً من التدوين، وانتهاءً بالإلغاء، متون الإلغاء كثيرة، لعلها أكثر من الجثث في كتب التاريخ، متفاوتة بين الخطابات التي تضم مساحات لا منتهية من الحدة والتهميش، ثم الإلغاء، فالموت.
جميع الخطابات التي تقوم بالإلغاء، هي خطابات ميتة في الأساس، لا تستطيع أن تحيا، لذا تقدّم للمختلف نعوشاً.
عكس عبارة “اللغة ديناميت” اللغة فردوس أرضيٌّ أيضاً، محاكاة بالفردوس المتخيل، كل فعل ينمو بشكل من أشكال الحياة، مثل فطرة الطفلِ، وإيماءاته الماثلة للحب والعطاء، ثم تأتي اللغة، إما تكون ملاذاً آمناً أو جحيماً.
أيّ أيديولوجية تحملُ فكرة التعصب، لغتها، طريقة التدوين، تقود نحو الموت، والأيديولوجيات لا تنتهي، ولن تنفد.
يبيّن أوليفييه روا في كتابه “الجهاد والموت” أنّ فكرة الانتحار الجمعي لم تكن نابعة من أيديولوجية دينية، حيث قام مقاتلو الحركة الانفصالية في سريلانكا “نمور التاميل” منذ الثمانينيات، باستعمال الحزام الناسف، أما في صفوف الجماعات الإسلامية، فيعود اللجوء إلى العمليات الانتحارية إلى سنة 1995.
داعش مجرد قناع آخر للغة الموت، أوالموت من خلال اللغة، “النصوص” كذلك أي جماعة تحمل دوافع الإلغاء والرفض.
مهجورة بلاد الناس في نصوصٍ، لا تترك أثراً سوى التباهي بالمأساة، وهو أثرُ لا يُرى إلا في خطاب الانتماءات، ذلك الذي يدعو للقتل والفناء، مهجورة أشجار البلاد، رغم المياه، رغم الحشود حولها، مهجورة جبال البلاد، وتلالها، وصخورها التي كانت تُلهم القادمين من السفوح، مهجورة الموجودات كلها، حين يكون الإنسانُ مهووساً بالحرب، وليست الحرب دماءً وأشلاءً فقط، الحربُ بمفاهيمها غير المحددة.
الحرب بَدءاً، وهي حديث لا ينتهي، بمفهوم نسقيّ داخل كل إطار يظهرُ واضحاً ضد ما يحلم به الفرد، وما يفعل من أجل الحرية، الحرب دون نهاية، وهي التي تضم كل النهايات في كُليّتها، بمعنى آخر: الحرب، تخضع لها النهايات، وهي لا تنتهي.
أدب النخبة، رثاء مؤجل:
أوقفتني كثيراً مقولة فرناندو بيسوا عن الجدلية بين النص والشاعر “كن شاعراً في كل ما تفعله، مهما يكن بسيطاً وقليل الشأن، كن شاعراً خارج النص قبل أن تكون شاعراً فيه” فكثيرٌ ما يُكتبُ الآن تحت مظلة النخبة، أخصّ الشعر لوحدهِ، هو محض هراء لا أكثر، في منعطف بيسوا/تلك العبارة، سقطت بروج شعراء، وانهارت فوق رؤوسهم، لأنّ الأدب عموماً، إذا لم يكن مرآةالإنسان، والذود عنه بكل مفاصل الوجود، فالأدب حينئذ ليس أدباً، والأدباء ليسوا سوى مرتزقة بأفواه لزجة، ولديهم القدرة على الانفلات والكذب بأسلوب حذق. فاللغة عندهم أداة نحر، والنصوص جثث، لم تظهر عليها الدماء بعد.
ما يفعل خطاب الإلغاء بكل اتجاهاته من قسوة وعنف، يفعله أدعياء الأدب من خلال الأدب، تلك ذريعة مخبوءة تحت الألسنة، وما أشدّها من ذريعة، خصوصاً في نبرة المواقف.
أؤمن ما ذهب إليه بيسوا من خلال مقولتهِ، وقد أطفأت حركية تتسم بالطوفان في رأسي، أطفأها وسِرتُ معه. لا يمكن للشاعر أن يكون له وجهين، وجه في النص، ووجه خارج النص، أو يدتكتبُ وأخرى تنحر.
ضحايا أبديون:
الذاكرة تجاه التاريخ تمرُّ عن طريق العبيد، التاريخُ بوصفهِ ملاذاً آمناً للحكام، منذ الشروق الأول للإنسان، منذ الإنسان، إلى آخرهم. كانت المسوّدات تُكتب بدم العبيد، وتطّهر بهم، هم ضحايا أبديون، هم ضحايا الألسنة واللهجات، العبيد متفرغون للإصغاء، متفرعون لأشباههم.
إشراق الكتاب:
حرق الكتب إحياءُ ثانٍ للكتاب، فهو ليس إعلاناً للموت، بل إعلانُ الخلود بصفة مريئة، تلك الظاهرة التي تحدث في جميع الحقب التاريخية وباستمرار، تلك الظاهرة لا تعلو إلا صوتاً واحداً، وهو صوت الحياة في شرايين النار، النار التي تشرق الكتاب.الكتابةُ ضد الكتابة من بابِ النفي والإلغاء، لا تسوّغ سوى فكرة الواقع الأول للبشريين، وهي الهيمنة والنفوذ، الهيمنة والموت.