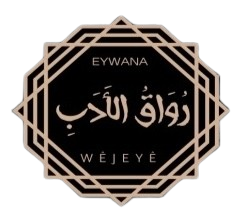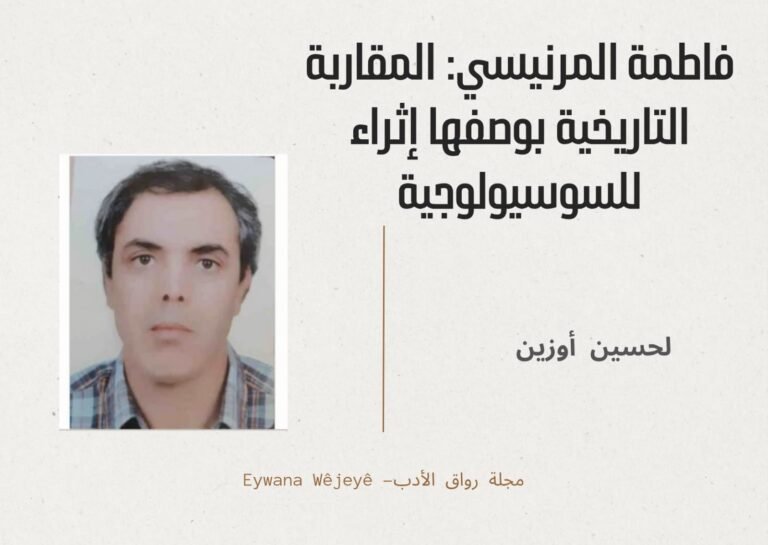البحث عن الصندوق الأسود في قصة مريم المجدلية وفي تاريخ الاحتلال
للكاتب المبدع باسم خندقجي – بقلم: أمل صيداوي

أنا كان عندي الشمعة
وكان عندك الضوء
فمن الذي سرق الفتيل؟
جاك بريفير
تراءت في الرواية هموم تشغل ذات البطل نور وتقض مضجعه وتملؤها بالكثير من المرارة والألم، وعلى الرغم من أن بطل الرواية عاش بغربة بين أهله وأن حياته كانت مليئة بالتناقضات إلا أنه حقق رغبته القوية في الدراسة الجامعية بفرع التاريخ والآثار.
سعى الكاتب ياسم خندقجي من خلال بطل روايته إلى تحقيق ثلاثة أهداف: الأول إنصاف مريم المجدلية عبر تماهيه مع شخصية أور الصهيوني ليتسنى له البحث عن صندوق مريم المجدلية لإثبات سيرة أخرى لمريم المجدلية غير السيرة التي كتبها دان براون في روايته «شيفرة دافنشي». ساعدت الظروف نور في العثور على بطاقة هوية زرقاء لشاب إسرائيلي يدعى “أور شابيرا داخل جيب معطف اشتراه من سوق الأغراض المستعملة، يساعده صديق “الشيخ مرسي الغرناطي الصوفي” بتزوير الهوية ووضع صورته مكان صورة أور. اسم نور معناه أور بالعبرية” نور شاب أشقر الشعر بعينين زرقاوين أخذهما من أمه التي ماتت أثناء ولادته، يساعده شكله وطلاقته في الحديث بالعبرية والإنجليزية، بإتقان دوره “كإشكنازي يرتدي قناع “أور شابيرا. وأما الهدف الثاني: فقد كان عبر اتّكاء نور على الأحداث التاريخية الهامة لتأكيد جذورالهوية والوجود الفلسطيني التاريخي المرتبط بالأرض. والهدف الثالث: رصد الأوضاع في الأرض المحتلة من تدمير للقرى وظلم وقمع واعتقالات.ولتوضيح الفكرة التي يريد الكاتب إيصالها تم تفكيك الرواية إلى عناصرها الأساسية وتحليلها على النحو الآتي:
عنوان الرواية والوظيفة الرمزية للقناع واللون الأزرق:
القناع: هو الوجه الآخر الذي يلبسه الإنسان أمام الطبيعة أو المجتمع لتمرير الأفكار والمواقف اللصيقة بالوجوه كملامح أصلية وعلامات مائزة بين تعدد المسالك والاتجاهات.
النواحي الإيجابية والسلبية لاستخدام القناع في الرواية:
النواحي الإيجابية:
أتاح انتحال بطل الرواية نور لشخصية “أور” من خلال استخدامه مصطلح “ارتداء القناع” الاستماع إلى جملة قالها بريان لـ بيتر وديفيد المشرفين معه على مشروع البعثة الأثرية: “اللعنة يبدو أننا نبحث في الموقع الخطأ” وهذا مايدل على أنهم فشلوا بالعثور على شيء معين في أعماق الموقع الأثري.
هناك موقف لنيكول البلجيكية التي سألت المرشد السياحي ناتان عن الحجارة القديمة الموجودة في الغابة فأجابها:” هذه آثار قديمة ياعزيزتي…هل نسيت أنت على أرض التوراة والعهد القديم”، لكنّها كذّبته بقولها:
” وهل نسيت أنت أنني خبيرة آثارية وأستطيع معرفة إذا ماكانت هذه الحجارة توراتية أم أنقاض قرية عربية مهجّرة في حرب استقلالكم”وهنا تقصد نيكول آثار قرية أبو شوشة المهجّرة”.
النواحي السلبية:
اضطر بطل الرواية وهو يرتدي قناع أور إلى التفوّه بالأكاذيب التي تتناقض مع إيمانه بوطنه وعدالة قضيته مثل قوله عندما كان جالساً برفقة إيالا إلى مائدة أوشرات بأن جميع الصهاينة فخورون بالجيش وسلاح الجو الصهيوني هاتفاً بشعار سلاح الجو الصهيوني”الجيدون للطيران”.وعند إجابته إيالا التي أعربت عن غيظها من العربية سماء اسماعيل التي لا تسأم من الحديث في السياسة ومعاني الهوية فيجيبها بقوله أن موقف سماء نابع من قناعاتها وأن بإمكان إيالا أن ترد عليها بموقف نقيض.
وأمام هذا الحضور القوي للقناع في الرواية، أحسسنا أن الكاتب يريد أن يطبّق قولاً لجلال الدين الرومي:
“عندما يتراكم عليك كل شيء،
وتصل إلى نقطة لا تتحملها،
إحذر أن تستسلم ففي هذه النقطة يتم تغيير قدرك.”
وهذا ماحصل مع نور حيث مزج الكاتب في هذا العمل التاريخ مع الأمل والحلم، فنرى كيف ينضج نور في ظل الحرب، وكيف أنَّ الحب ينبت على الرغم من الحرب ويخلق معه أملاً جديداً وطريق كفاح لا ينتهي، فقد اعترف نور للفلسطينية سماء إسماعيل بحبه لها بعد إصغائه لمناقشاتها مع الأمريكيين والإسرائيليين أثناء اشتراكها في أعمال التنقيب والتي أعربت فيها عن هويتها العربية وعن الظلم الذي لحق بالفلسطينيين من جراء الاحتلال الإسرائيلي. يخرج نور من الكيبوتس عندما أُلغيت عملية التنقيب ويركب سيارة سماء خارج الكيبوتس، وبعيد برمجة هاتفه من العبرية إلى العربية.
اللون الأزرق:
بالرجوع إلى لوحات بابلو بيكاسو في الفترة المسماة: الزرقاء والتي بدأت عام 1901م ..وانتهت عام 1904م. سيطرت خلالها على لوحات (بيكاسو) مواضيع مأساوية حزينة استخدم في رسمها “اللون الأزرق” .. ودرجاته .. بشكلٍ طاغٍ ..ولهذا سُميت بالزرقاء وهي الفترة التي أعقبت انتحار صديق (بيكاسو) .. الشاعر الفرنسي (كارلوس كاسيجماس) ووفقاً لما سبق فإن اللون الأزرق في العنوان رمز للمأساة الفلسطينية.
نستنتج مما سبق أن العنوان كان الممهّد الأول لتبرير الدخول لتاريخ مريم المجدلية، لذا كان العنوان مناسباً ومرتبطاً مع المتن الروائي بصورة واضحة.
المكان:
تدور الأحداث في أحد المخيمات الفلسطينية في فلسطين المحتلة، وفي رام الله والبيرة وفي قرية أبو شوشة.
الشخصيات الرئيسية
تدور الأحداث في رواية قناع بلون السماء بين عدد من الشخصيات الرئيسية، وهي كما يأتي:
نور مهدي الشهدي: بطل الرواية وابن نورا كردانة التي توفيت حين ولادته. باحث مختص في التاريخ والآثار كان لديه هدف ألا وهو البحث عن صندوق مريم المجدلية لإثبات سيرة أخرى لمريم المجدلية غير السيرة التي كتبها دان براون في روايته «شيفرة دافنشي» والتي ادّعى من خلالها بأن الكنيسة أخفت زواج المسيح من مريم المجدلية، وأنها أنجبت له ولداً.
مراد: صديق نور المقرّب والذي تم اعتقاله من قِبَل قوّة خاصة لجيش الاحتلال الصهيوني وهو يتمشى مع صديقه نور في أزقة المخيم، وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة تخطيط عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال، ومازال رهن الاعتقال منذ عشر سنين.
الشخصيات الثانوية:
مهدي الشهدي: بطل الإنتفاضة وسيّد أزقة المخيّم والمطارد الذي لقّن أعداءه دروساً في المقاومة حُكِم بالسجن لمدة خمسة وعشرون عاماً ثم تمّ الإفراج عنه بعد توقيعه تعهّد بعدم العودة للعنف، وهو والد نور.
الشيخ “مرسي الغرناطي الصوفي”: لاجئ مشرد من بيته الأول الذي كان يقع في حارة المغاربة التي أحالتها جرافات مزودة بمحركات توراتية إلى ساحة لحائط البراق الذي صار حائط المبكى على هيكل سليمان عشيَّة نكسة 1967 واحتلال فلسطين بأكملها لاجئ “ساعد نور بتزوير هوية اور ووضع صورة نور مكان صورة أور”.
سميّة ( أم مهدي): جدّة نور من طرف والده التي ربّت نور بعد وفاة والدته. توفيت سمية في الذكرى الخمسين للنكبة.
خديجة: خالة نور (أخت أمه) وأرملة الشهيد فراس صديق مهدي والتي تزوجت مهدي فيما بعد.
أم عدلي: والدة مراد التي كان ابنها مراد يدعو نور لطعام الإفطار في شهر رمضان المبارك. كانت تزور ابنها مراد في المعتقل كل شهر.
سماء اسماعيل: الفتاة الفلسطينية من حيفا شاركت في عملية التنقيب ووقع نور في حبها.
أيالا شرعابي: اليهودية الشرقية المتعصبة للصهيونية .
أور شابيرا: اسرائيلي أشكنازي (رمز للقناع الذي ارتداه نور). تقمّص نور شخصية أور لكي يستطيع الالتحاق ببعثة التنقيب عن الآثار.
تحليل الرواية:
من أجل تحقيق الهدف الأول لبطل الرواية تجرأ نور وارتدى قناعاً صهيونياً أشكنازياً، والتحق بالعمل مع مؤسسة أميركية تنقب عن الآثار في كيبوتس “مشمار هعيمق” المقام على أراضي قرية أبوشوشة المهجرة.
على الرغم من أن مراد نصح صديقه نور أن يتجه كخبير آثار للتأكيد على ملكية أراضي الشيخ جراح بصفتها قضية أهم وأكثر إلحاحاً من البحث في تاريخ مريم المجدلية لكن نورأصرّ على البحث عن صندوق مريم المجدلية ليثبت بعض الوقائع التاريخية، والتي جرت في “اللجون” أو مسيانوبوليس، أو مستوطنة مجدو.
ورد مصطلح الغنوصية في الرواية والذي هو حسب تعريف المراجع: “من الناحية اللغوية؛ فإن كلمة الغنوصية مشتقة بالأساس من لفظة gnosis اليونانية، والتي تعني المعرفة/العرفان. و”الغنوص Gnosis” هي كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكل عام، ولها أشباه في عدد من اللغات الهندوأوروبية مشتقة من الجذر نفسه، مثل الكلمة السنسكريتية “جناناJnana ، والكلمة الإنكليزية Know بمعنى يعرف، وKnowledge بمعنى معرفة” والمقصود بالغنوص المعرفة الباطنية التي تنطلق من عمق الإنسان، ولا تطلب شيئًا خارجه. وموضوعها هو الأسرار الإلهية، التي لا يرقى الجميع لمعرفتها، بل تخص فئة معينة، ترتقي فوق العامة الذين لا يعرفون إلا ظاهر الأمور. وهي شكل من المعرفة الدينية موضوعها واقع الإنسان في حقيقته وروحانيته، نقلها “مُخلّص” فكشفها في تقليد باطني خاص؛ فاستطاعت هي بدورها أن تخلّص الذين يتقبلونها. ولكن المعرفة التي يسعى إليها الغنوصي ليست تلك التي يكتسبها بإعمال العقل المنطقي وقراءة الكتب وإجراء التجارب والاختبارات، وإنما هي فعالية روحية داخلية تقود إلى اكتشاف الحالة الإنسانية، وإلى معرفة النفس، ومعرفة الله الحي ذوقًا وكشفًا وإلهامًا. وهذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروح الحبيسة في إطار الجسد المادي والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانية هي قبسٌ من روح الله، وشرارة من النور الأعلى وقعت في ظلمة المادة، ونسيت أصلها ومصدرها. تبنّى الكاتب الرؤية الغنوصية لمريم المجدلية بقوله:
“تتحدد الرؤية الغنوصية بالإجابة على عدة أسئلة، من أهمها : من نحن ؟ ما نحن؟ إلى أين نحن ماضون؟ ما هو النور؟ وكيف تولد من النور ؟ ولماذا يرى الغنوصي أنه غريب عن هذا العالم ؟”
وما يهمني في ضوء الرؤية الغنوصية هو إجراء دراسة تحليلية نقدية لطبيعة العلاقة بين بطرس والمجدلية، التي يمكن اقتفاء أثرها في بعض المدارس الغنوصية التي كانت منتشرة بعد صلب يسوع على مدار القرنين الميلاديين الأولين. ومن أهم النصوص التي تكشف عن طبيعة العلاقة بين بطرس والمجدلية نص مسيحي غنوصي اشتهر باسم pistis sophia» ينقله ويترجمه لنا فراس السواح في كتابه ألغاز الإنجيل، حيث نجد في أحد المشاهد أن بطرس يتذمر من احتكار مريم الحوار مع يسوع في تجاهل لأسبقيته، ويطلب منه إسكاتها، ولكن يسوع يعنفه على موقفه هذا. وبعد ذلك، تقول مريم ليسوع بأنها لا تستطيع التحدث معه بحرية خوفًا من بطرس الذي يكره جنس النساء، فيقول لها يسوع :
“إن من يلهمه الروح هو المخول بالكلام رجلاً كان أم امرأة”.
بالعودة إلى رأي الأناجيل الأربعة: “متى، وحنا ومرقس، ولوقا” بمريم المجدلية ورأيهم فيها ونظرتهم إليها فقد أجمعت الأناجيل الثلاثة إنجيل متى وإنجيل حنا وإنجيل مرقس على مايلي حسب ماورد على لسان الكاتب: “مريم المجدلية هي امرأة ثرية من قرية مجدلة، تعمل بالتجارة وتمتلك بيتًا فخما في القدس – بيت عينيا. ولكن ثمة مس شيطاني يُصيبها بسبعة شياطين، فتهجر أهلها وتجارتها وتتشرد في الطرقات والبراري، فتتورط بالبغاء دون وعي منها، إلى أن يخلصها يسوع من شياطينها وبغائها، فتعود إلى رشدها لتكافئه بالعطر مؤمنة به داعمة له، مما يجعلها ذات حظوة عنده”.
أما في إنجيل لوقا فقد ورد أن يسوع خلّص مريم المجدلية من شياطينها السبعة لكنه يذكر بأنها خاطئة وهذه الخاطئة بحسب الرواية الإنجيلية من مدينة نايين الجليلية هي من سكبت الطيب على يسوع وبللت قدميه بدمعها ومسحتهما بشعرها.
ولتحقيق الهدف الثاني من الرواية ألا وهو تأكيد جذور الهوية والوجود التاريخي الفلسطيني المرتبط بالأرض وصف الكاتب مراحل الزمن التي مرّت على قرية أبوشوشة الفلسطينية :
“أقيمت مستوطنة مشمار هعيمق على أنقاض قرية فلسطينية مدمرة كانت تسمى أبو شوشة”، وتبين لي من خلال البحث عن تاريخ تلك القرية أنها تقع إلى الغرب من موقع تل أبو شوشة الأثري. وكان يصلها بحيفا وجنين الطريق العام الذي يمتد بين هاتين المدينتين”. كما تكلم الكاتب عن ثورة “بار كوخبا”التي ذُكر عنها وبالعودة إلى المراجع تبين لنا مايلي:
“هي تمرد مسلح واسع النطاق بدأه يهود المقاطعة اليهودية بقيادة شمعون بار كوخبا ضد الإمبراطورية الرومانية سنة 132م، واستمر حتى سنة 136م، وهو التصعيد الثالث والأخير في الحروب اليهودية الرومانية. مثلما حدث في الثورة اليهودية الكبرى وحرب كيتوس، انتهت ثورة بار كوخبا بهزيمة يهودية كاملة؛ قُتل بار كوخبا على يد القوات الرومانية في بيتار سنة 135م، وقُتل أو استُعبد جميع المتمردين اليهود الذين بقوا بعد وفاته خلال السنة التالية. بعد ثورة بار كوخبا، انتقل تمركز المجتمع اليهودي إلى الجليل بدلاً من المقاطعة اليهودية. كما أُجبر اليهود أيضًا على سلسلة من القوانين الدينية التي أصدرها الرومان، بما في ذلك قانون يمنع جميع اليهود من دخول القدس”، وهذا مايدحض مزاعم الإسرائيليين بأن القدس عاصمة دولتهم.
خلقت السياسات والممارسات الإسرائيلية، بيئة تشبه الغيتو القديمة الذي تمّ تعريفه بالمراجع: “المَعزِل أو الغَيْت يشير إلى منطقة يعيش فيها طوعاً أو كرهاً، مجموعة من السكان يعتبرهم أغلبية الناس خلفية لعرقية معينة أو لثقافة معينة أو لدين. أصل الكلمة يعود للإشارة إلى حي اليهود في المدينة، مثل الغَيت في مركز مدينة روما. يرجع أصل مصطلح “الغيتو” (Ghetto) إلى اسم الحي اليهودي في البندقية الذي تمت إقامته عام 1516, وأجبرت السلطات البندقية يهود المدينة على العيش فيه. وأمر الكثير من الزعماء مثل السلطات المحلية أو الإمبراطور شارل الخامس بتأسيس الأحياء اليهودية في فرانكفورت وروما وبراغ ومدن أخرى في القرن السادس عشر والسابع عشر”. تكمن أوجه التشابه بين الغيتو القديمة والغيتو الحديثة في أنه تم عزل الفلسطينيين في مناطقهم وتقييدهم في حريتهم وحقوقهم من قِبَلْ الاحتلال الإسرائيلي. فالهدف هنا لم يكن التأريخ للحقبة الزمنية بقدر ما كان استخدام التاريخ كمجازٍ وأداة للتعبير عن الواقع المُعاش.
أما الهدف الثالث من هذه الرواية الذي هو رصد الأوضاع في الأرض المحتلة فقد تجلّى في سرد الكاتب للأحداث والتفاعلات التي مرّ بها والد نور في قوله:
“والد نور الذي اعتُقِل بعد زواجه بأسابيع وبقي مسجوناً خمس سنين أضحى عند خروجه من السجن مصموتاً مخذولاً وصار يبيع شاياً وقهوة على عربة ثم تزوج من أخت زوجته”. وتجلى أيضاً في وصف طريقة اعتقال صديقه مراد: “وقعت الواقعة التي خططت لها قوة خاصة لجيش الاحتلال الصهيوني، وعملت على تنفيذها بإتقان؛ إذ تنكر بعض أفرادها بملابس نسائية فانتزعت القوة مراد بسرعة البرق من حواره مع نور”. وفي وصف الأحداث المؤلمة التي تعصف بالأرض المحتلة: “ينتشل هاتفه من جيبه يدخل إلى موقع إخباري فلسطيني، يقرأ على عجل عناوينه :”الاحتلال يعتدي على المزارعين في الأغوار الشمالية .الاحتلال يُجبر مواطنًا مقدسياً على هدم بيته على نفقته الخاصة بحجة عدم الترخيص .تصاعد التوتر في القدس بعد إعلان بلدية الاحتلال نيتها إخلاء العائلات المقدسيّة من بيوتها في حي الشيخ جراح” .
السمات الفنية في رواية قناع بلون السماء
بعد قراءة رواية “قناع بلون السماء” يلاحظ أنها تتسم بعدد من الخصائص والسمات الفنية، منها على سبيل الذكرما يأتي:
– اعتماد مسارين زمنيين في الرواية زمن الماضي التاريخي وزمن الحاضر
– استخدم الكاتب في نقل أحداث الرواية الطابع السردي بضمير الغائب والمتكلم والمخاطب في فصول الرواية السبعة.
– اللجوء إلى الاستطراد في بعض مواضع الرواية.
– استخدام الحوار المباشر وغير المباشر وحوارات متخيلة مع صديقه مراد.
– اللجوء إلى وصف الأماكن والأشخاص والأفعال بدقة.
– توظيف العديد من العبارات والألفاظ التي تحمل دلالات دينية.
– إظهار الشخصيات كمحور للأفكار والآراء ومصدراً لرسم الواقع.
رواية “قناع بلون السماء” رواية إبداعية
أفضى الكاتب في روايته بهموم تشغل ذاته وتقض مضجعه وتملؤه بالكثير من الحزن والألم منها قضايا وجودية مؤرقة ومنها قومية شائكة. تواشجت في نص المتن القصص واختلفت وتنوعت لتصب في قالب فسيفسائي تمّ إخراجه في قالب إبداعي مبتكر. كانت الرواية أداة تعرية للاحتلال حيث صوّر الكاتب كذب مزاعمه بوجوده التاريخي في فلسطين، كما صوّر وحشية الاحتلال. يعتبر طرح الكاتب حول الغنوصية طرحاً هاماً ومثيراً للتفكير لمسنا من خلاله التجديد فقد بارح الكاتب ما هو مألوف إلى اللامألوف، لما احتوته الرواية من براهين استخدم في سردها الاسترجاع التاريخي بشكل توصيفي مدهش ودقيق يجذب اهتمام القارئ، وكأن الكاتب يطلب من خلال طرحه هذا إعادة النظر في المواقف المعلنة من مريم المجدلية، لذا فإن رواية “قناع بلون السماء” هي عبارة عن بحث مستمر عن أساليب جديدة، تثير لدينا شهوة المعرفة والبحث.