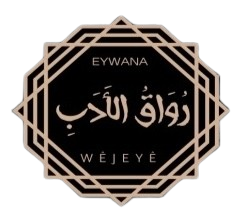عن اَلفاتن والفريد واللّامتوقع: هذا هو الشّعر…!
*خالد حسين
 |
| اللوحة: من موقع سفير آرت |
في ضيافة الكلمة الشعرية (1)
عتبة
“اللا ــ متوقع” هو الصّدعُ الذي يطلُّ منه الأدبُ وكلُّ إبداع…!
I
لا أنظرُ
إلى الشِّعر إلا كانفتاح فادح، إلا كفرط افتتانٍ، َوكلُّ منهما يجدُ في التعميةِ أصلٌ له بوصف العَماء مسكن الشِّعر، الأرض التي ينطلق منها سحرُ الكلمة الشعرية…
II
يجري الحديث عن علاقة سرية بين الشّعر والفلسفة؛ لا الشعر يعتاش دون فلسفة ولا الفلسفة بإمكانها أن تنزع ذاتها من مراوغات الكلمة الشعرية وفخاخها، الأمر يمضي نحو شعرنة الفكر أو الفكر في إهاب الفلسفة…كلاهما ـ الشعر والفلسفة ــ يفتح للدهشة أفقاً…!!!
لماذا يجنح الفلاسفة إلى الشِّعري؟
ما الذي يدفع الفلاسفة إلى الوقوع في مصائد “الكلمة الشعرية”؟
لا أجوبة محددة لدي في الواقع سوى القول:
سيبقى “الشِّعر” ذلك السرُّ الذي لابدُّ منه كي يستلذُّ بنا الجنوحُ إلى ما لا ندركه، السر الذي لا ينفك يطارد الفلسفة ذاتها أنى ارتهنت لمفاهيمها ومقولاتها؛ ليدخل القلق إليها ثانيةً ويعرّضها لعاصفةٍ من الإبهام والالتباس..
III
اَلعمقُ الشّعريُّ،
العمقُ المبهمُ، العمقُ الغامضُ، العمقُ الذي يمنحُ الوجودَ معناهُ وجمالَهُ وكثافتَهُ …
إنه هنا:
يسكن أصوات النّساء وبين أصابعهن، ينمو في رغباتهنّ الأكثر اتصالاً بقوى الطبيعةِ والحياةِ…
IV
المضيُّ
باللغةِ إلى تضاريس غير موطأة أو ما يُسمّى بالتفجير اللغوي أو الانزياح أو الانحراف… لا يكون بغاية الإبهار بقدر ما يكون هذا الاشتغال هو انعكاس وتمثيل للرؤية التي يرى بها الشاعر اللغة في علاقتها بالعالم والذات، الرؤية التي ينطلق بها ومنها الشاعر لرؤية العالم هي التي تحدّدُ شكل اللغة لصناعة المعنى….ومن ثمَّ فهذا الاشتغال المختلف والمغاير يشكّلُ استراتيجيةً من جملة استراتيجيات تتعاضد فيما بينها لبناء القصيدة إلى جانب اللامتوقع، منطق اللاقص، تنويع الخطاب، الممارسة الاقتصادية للعلامات اللغوية في سياقاتها الشعرية…فتجارب سان جون بيرس، باول تسيلان، سليم بركات، درويش، ….إلخ نماذج على ما أقول…
V
الشّعر
أن تنصت للغة بدايةً؛ ثم تدعها ـ تدع اللغة ـ تكتبك بضراوة خيالها الآسر…!!
VI
القصيدة، الشّعر، الصّورة؛
هذه العلامات حينما تندغم ويتلاءم بعضُها مع بعض يمكنها أن تُحْدِثَ فجواتٍ وانحناءات وتقوّسات في اللغة وتفرض عليها أن تلتوي على نفسها وتلتفَّ بفعل وطأة قوى الضغط، اللغة في الشِّعر كأرضٍ في حالةِ طَيٍّ…
VII
في ضيافة الكلمة الشعرية:
أن نكون في ضيافة الكلمة، هو أن ننزلَ إليها «ضيفاً»؛ أي نكون بالقرب منها؛ فالضِّيافةُ تفترض الدنوَّ والميلَ والاقترابَ، وما يترتَّبُ على ذلك من أُنسٍ وأُلفةٍ بين المضيف والضيف، بين «الكلمة الشعرية» والقارىء، الكلمة بوصفها المضيف والمضيفة (موضع الضيافة)، لا تملُّ من استضافتنا؛ لهذا لا تكفُّ عن مناداتنا عن الدعوة للاقتراب منها، والنزول إليها. ففي ندائها لنا، وتكلُّمها بنا؛ نغدو معها: الفسحةَ والمنفذَ والفجوةَ التي يُطلُّ منها «العَالم»، فنحن والعالم مرهونان في تكشُّفِنا وانكشافِنا واحتجابِنا بكلام «الكلمة الشعرية» وصمتها، بانفتاحها وانغلاقها، بإنارتها وعتمتها. أن نكون في ضيافة الكلمة هو أن نحاورها، نحاورَ الكائن الذي يسكنها، الوجود الذي يقيم فيها، السرُّ الذي يلوذ بها، فالضيافةُ، حيث يقع «الحوار» حدثاً، لا تنفكُّ موضعاً لانكشاف الأسرار، وإضاءة الضيف والمضيف؛ ففي الحوار تضيئنا «الكلمة»، ننهض بها وتنهض بنا؛ لهذا فنداؤها واجبٌ ينبغي أن يُلَبَّ؛ فهي لا تنادينا إلا إذ كانت مكتظةً بالأسرار. وتبتغي إفضاء السرِّ، سرّ الكينونة، به، بالكائن، وله…
VIII
الشّعرُ انبثاقٌ الرَّغبةُ في صورتِهَا الوحشية…!
IX
النَّصُّ العَالي،
النَّصُّ السَّاميُّ، النَّصُّ الذي لا يَسمحُ لك باستكمال قراءته، النَّصُّ الذي لا يكفُّ عن تدقُّق اللذة ومحاصرتك بالتخييل، هذا النَّصُّ الفاخرُ ليس إلا الليل وقد انغمسَ بفداحةٍ في غوايةِ الشَّكل ــ النّهار…!
X
القصيدة الشعرية،
القصيدة الحقة لا تُكتب لكي تُستهلك بقراءة واحدة، القصيدة الحقيقية تقضُّ مضجعَ المؤوّلين والقرّاء مدى أعمارهم، القصيدة الحقيقية تقود قراءها إلى السَّراب ثم تتكىء على حافة التاريخ، لتتأمل صراع التأويلات بغبطةٍ…
XI
ندرة
ندرةُ الشعر تكشفُ عن قوّته، عن حضوره الأخّاذ في الفتك بالانتباه والاستغراق فيه، هذه الندرة غالباً ما تكون نادرة حتى في “القصيدة”ــ موطن الشعر ذاته…في الشعر ــ النادر نلمس بأصابع الشعراء ضفافَ الآلهة …!!
عن سؤال ما الشعر؟ (2)
I
الكلمة الشعرية: تكثيف للكينونة، نداء للامرئي…
II
القصيدةُ لسانُ السّيمياء…!!
III
في انبثاق القصيدة …
نحاول الإمساك بظلالٍ ضائعة!!!
IV
الشِّعرُ يفتتحُ دروباً لا تَقُوْدُ إلى أيِّ مَكانْ…؟
V
غير أنّ “الكلمة الشِّعرية” لها منطق آخر في الحضور، ذلك أن العوالم المفاجئة مشروطة بحضور الشِّعر، الذي لا ينفك يحضر بعد غياب، فالشِّعر مثل الكينونة يغيب، ولكنه برسم القدوم؛ فلا يمكن للكينونة أن تكون دون حضور الشِّعر.
IV
الكلمة الشّعرية تسعى إلى رسم “جمالياتّ الصمت”، اللامرئي، واللامقول ولذلك تحتاج من الشاعر إلى المداراة والاهتمام والاختيار والصون بعيداً عن الضجيج. إنها الكلمة المشغولة بقول “الصمت”؛ لتقول العشب والنَّهر والصّدى والموت والكينونة بهدوءٍ مبدع…!
VII
“…الشّعر ليس إنشاداً؛ وإنَّما بناء يُتيحُ التوطَّن في الأرض، وهو بذلك ليس ترفاً في القول بقدر ما هو الإبانة أو الثَّغرة التي يتقدّم من خلالها العالم ليعلن حضوره….”
صوت من الغابة السوداء
VIII
الشّعر وارتكاب العنف
يستهدف الشّعرَ النظام الدلالي السَّائد ــ والمترسّخ ـــ للغة بعنفٍ وضراوةٍ تبعاً لمنطقِ الشَّاعر [أقصد الشاعر الهدّام] ورؤيته الفلسفيةِ للغةِ والحياةِ؛ ليحدثَ من ثمَّ صَدْعَاً، هوةً، تباعداً بين (اللغة والمرجع)، فتنبثقُ دلالةً تتسمُ بالاختلاف والغموض واللاتحديد والانزياح أو العدول حسب عبد القاهر الجرجاني، وهو ما يُوهم بأنَّ ثمة تعميةً تترامى على مَسَاحَة النَّصّ الشِّعري نتيجة خروقات وارتكابات كثيفة للاستبدلات والاستعارات والمجازات والتَّنَاصّ. وهكذا نجد أنفسنا إزاء نصيّةٍ مغايرةٍ تنطوي على دلالةٍ معمّاةٍ تتّسم باللاحسم على الصَّعيد الدّلاليّ، فالعلامة اللغوية في هذه النَّصيَّة، لم تَعُدْ تضافراً بين الدَّال والمدلول وإنما التحاماً بين خاصتي: (الاختلاف والإرجاء)، فالعلامة الشِّعرية حتى تكون علامةً، عليها أنَّ تختلفَ عن علامات أخرى وترجىء معناها من قراءةٍ إلى أخرى وهذا ما يُطلق عليه “اللاحسم” دلالةً تحت وطأة “النصية” التي تعمل على إخفاء قواعد النّصِّ وأسراره.
IX
لا تنفكُّ الكلمةُ الشِّعريةُ عن مقاومةِ، بل مواجهةِ الثرثرة بكلِّ العتمة التي تنطوي عليها، لذلك سنرى الشعراء العظام يلجؤون إلى أعلى درجاتِ استثمار اقتصاد العلامات، اقتصاد النص في التكثيف والاختزال لكي يتدفق الصّمتُ إلى جغرافيا النّص الشَّعري، وهذا وحده ما يتيحُ للصّمت أن يتكلّم إلينا، ما يتيحُ للقصيدة أنّ تحاورَ العالم دون أن تتلاشى.
X
عن سؤال ما الشعر؟
…. اَلنَّصُّ الشِّعري يتأسَّسُ على الفتك بالقوانين التداولية للكلام من حيثُ إنَّ النّسجَ الشِّعريَّ عنفٌ يُمارس بحق اللغة نحواً وصرفاً وصوتاً ودلالةً وإزاحةً مما يمضي بالنّصّ الشّعري إلى التنائي عن المتعارف عليه من صيغ الكلام التداولي، ليسكن بذلك أرض الغرابة؛ الأمر الذي يصنع الدّهشة والمفارقةُّ والتَّعجُّب لدى المتلقي. وإذا أضفنا إلى ذلك حذاقة الشَّاعر ومهارته في النسج (الشعراء أمراء الكلام كما يُقال في العربية)، فإنّ التعمية تتضاعف وتهيمن على الكلمة الشِّعرية، وهذا ما يجعل الكلمة الشعرية تحديداً تضيئنا بعتمتها.
XI
الشعر ــ تفرُّد الصّوت
…. والشّعر هو تفرُّد الصّوت، فسحةٌ للصوتِ في خصوصيته، في انبثاقه ـــ التفرّد شرطٌ لحضور الشِّعر ذاته، أيْ إنَّ حضورَ الشِّعر بوصفه انعطافةً حادّةً في اللغة ووجهة النظر والتَّجربة في العالم ومعه يفرضُ خصوصيةً في الصَّوت الشِّعري وفرادته؛ إذ تتدرّج هذه الفرادة من صوتٍ إلى آخر تجذُّراً من عدمه في أرض الكلمة الشِّعرية. وهذا لا يعني شيئاً سوى “الاختلاف”، اختلاف الصّوت، البصمة، الإمضاء؛ ليكونَ ذلك ممرّاً إلى استعمال مفهوم أكثر دقةً وتلاؤماً مع الشِّعرية المعاصرة وأعني الكتابة الشِّعرية في صميم الاختلاف، “الكتابة ــ الاختلاف” وفي المسافة الفاصلة بين الكتابة والاختلاف تقيم التجارب الشِّعرية درجةً ونوعيةً، ثراءً وفقراً، ألقاً وخفوتاً إلى أن تبلغَ بعضها ضفاف “الكتابة اختلافاً” حَدّاً وقوّةً أو تنهار في الطريق إلى هذه الضفاف.
XII
“الشِّعر، القصيدة”
…”الشِّعر، القصيدة”، ضمن هذا الحقل المفهومي نُباينُ “الشّعر” عن “القصيدة” بالنّظر إلى الأخيرة بوصفها مكاناً، فضاءً لِسُكْنَى الكلمة الشّعرية، فالشّعر إما أن يتخذ القصيدة مأوى أو لا يكون، كما لو أنّ القصيدة، وهي كذلك واقعاً وحدثاً، هي التي تمنحُ الكلمة الشِّعرية نعمة الإقامة والتمكُّن والحضور، والبروز، والإشراق، والانخطاف. وفي الوقت الذي يرتهن فيه حضور “الشِّعر” بالقصيدة شرطاً، فإنها تحضر في كثير من الأحيان إلى الكتابة مع كائناتها اللغوية دون كائن الشّعر ذاته من حيث هو سحرٌ وفتنةٌ وغرابةٌ، وهي دون الشِّعر، بعيداً عن الكلمة الشِّعرية، تحيط بعالم من الهمود والانطفاء والأفول والخفوت، فهي ليست، والحالُ هذه، إلّا ضرباً من الفضاء المنكفئ على ذاته. لكن ندرةَ الشّعر، وهي خاصيةٌ، أصلٌ في الكلمة الشِّعرية ذاتها، تحدّدُ تألق هذا “الفضاء ــ القصيدة” من تلاشيه. وإذا كان ألقُ القصيدة مرتهنٌ بتمكُّن الشِّعر منها إقامةً وسكناً فهي إذاك ضرورةٌ، نداءٌ للكلمةِ الشِّعرية للحضور وبثّ سحرها وإشراقها في أرجاء القصيدة حتى تحضر “القصيدة ـــ الفضاء” ذاتها إلى الرؤية وتقف إزاء الفكر دافعةً إياه لواقع تأويلي مغاير.
كتابة الشّعر، أو الرواية، أو النقد، أو الرسم أو… إلخ هي محاولة أو محاولات يائسة لكي “نفهم” العالم، ولكننا في كل انعطافة نطارد العالم فلا نصطاد سوى ظلاله….
خالد حسين، أكاديمي كردي، تولّد منطقة قامشلي(سوريا) 1965؛ حاصلٌ على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من قسم اللغة العربية بكلية الآداب ـــ جامعة دمشق، 2005. عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب الثانية (السّويداء).
صدر له من المؤلفات:
ــ شعرية المكان في الرواية الجديدة، الرياض: مؤسسة اليمامة، ط1، 2000. وصدرت ط2 في دمشق: دار التكوين، 2023.
ــ في نظرية العنوان (مقاربة تأويلية في شؤون العتبة النّصية)، دمشق: دار التكوين، ط1، 2007، وط2، 2003.
ـــ شؤون العلامات: من التشفير إلى التأويل، دمشق: دار التكوين، ط1، 2008. وط2 قيد الطباعة في الدار ذاتها.
ــ اقترافات التأويل: مقاربات في الشعر والنقد والنقد الثقافي، العين: دار جميرة، ط1، 2015. والطبعة ط2 قيد الطباعة في دار أوغاريت بدمشق.
ـــ سيميائيات الكون السّردي: دراسة نقدية، لندن: دار رامينا، ط1، 2023.
ــ نداءٌ يتعثّر كحجر: شعر، لندن: دار رامينا، ط1، 2023
الترجمات
ـــ الحقيقة التي تجرح: تقويض، آدب، حوارت: جاك دريدا وكريستوفر نوريس، دمشق: دار التكوين: ط1، 2023.
ــــ في العزلة والأدب وجماليات الصمت: موريس وبلانشو وآخرون، دمشق: دار التكوين، ط، 2023.
قيد الإصدار قريباً
ـــ منطق التقويض ورهاناته: مجموعة مؤلّفين(ترجمة)/ دار التكوين.
ـــ شؤون العلامات: من التشفير إلى التأويل(ط2)، دار التكوين.
.ـــ العلامة الشّعرية: سحر الأثر، كثافات المعنى، اقتصاد النصّ، دار AVA.