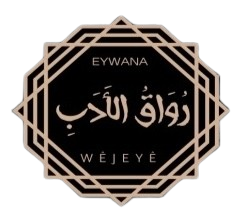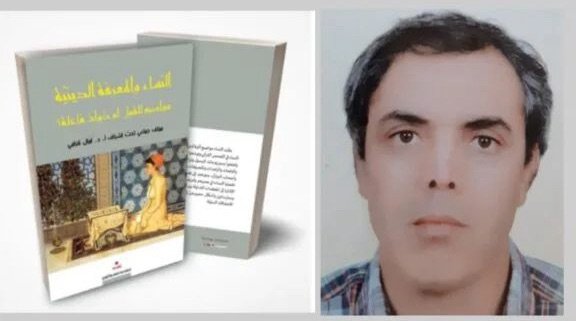الذات الكردية المتشابكة
عبد الناصر حسو*
أثير هنا جملة تساؤلات، هل هناك
بالتحديد ثقافة نقية صافية لم تتأثر أو تتسرب إليها ثقافات أخرى؟ أو هل هناك صورة
نقية وهوية صافية ومنعزلة، متواجدة في العالم؟ لعل أكثر الثقافات غنى هي التي
تنفتح على الاخر. لقد استحضرتْ مرحلة المابعديات (مابعد الحداثة، مابعد العلمانية،
مابعد المذاهب، مابعد الكولونيالية..) صورة ذات مواصفات خارقة للتعبير عن هوية
(الأنا)، لاستحضار هوية (الآخر) بوصفها هوية فاضحة، مفككة، معرّضة للاتهامات
المستمرة باعتبارها خارج سياق الانتماء ومنطق التاريخ، وهي صورة سياسية أكثر مما
هي صورة ثقافية/ حضارية، يحدث هذا في الازمات والحروب والهزائم دائماً.
النقاء، مجرد وهم في جميع مراحل
التاريخ، ولدى جميع الشعوب والافراد، لا يوجد نقاء ثقافي، ولا توجد هوية أصيلة،
ثابتة، منجزة، سكونية، مهما كان وضع المجموعة البشرية التي أنتجت تلك الثقافة
منعزلة، تعيش داخل أسوار فولاذية وتُمنع رياح الثقافات ورياح التغيير أن تهب على
نوافذها، لذلك، فالثقافات متلاقحة، متمازجة، متواصلة تشكل هوية ثقافية في فضاء
هجين، متناسج، ويتيح الاختلاف الثقافي أن ينمو ويساهم في انتاج معارف جديدة، وهذه
ميزة جميع ثقافات العالم. هذا التناسج حيوي، ثري، غني بالأشكال والأفكار
والأساليب، تسمو نحو العالمية وليست إلى العولمية (الأمركة) كما يدّعي مؤيدو
العولمة، لذلك، فالثقافات، جميعها من دون استثناءات هي ثقافات عالمية كونها تحافظ
على خصوصياتها البيئية والاجتماعية.
العديد من مرويات الشعوب، متشابهة، متماثلة
من حيث القيم الثابتة، ومختلفة من حيث الوسائل والأدوات، يمكن القول إن في كل
العصور والاحقاب توجد حكايات وملاحم وتجارب إنسانية متشابهة، ترتقي إلى مستوى
العالمية، رغم أن ظهورها تأخر لدى بعض الشعوب والأمم، لأسباب عديدة قد تعود في
بعضها إلى التطور الاجتماعي والثقافي. تتوالد
الأسئلة في كل مرحلة تطال المجتمعات البدائية والمتقدمة، هل يتوجب علينا أن ننتظر
أجوبة متشابهة، متناقضة، منسجمة حتى نستكين؟.
المقارنة بين ثقافتين مختلفتين
متباعدتين زمانياً ومكانياً، هي عملياً مقارنة في النتائج، نتائج احداها قادت إلى
طريق القوة والرفاهية، واستعبدت الثقافة الاخرى، وهذا لا يعني أن الاخرى كانت أقل
قيمة بالنسبة لمجتمعها، لكنها (كانت تعيش على اسس ثابتة لا تشجع على التقدم، وكان عليها
أن تتخلى عن الأسس الاجتماعية التي هي منبع الضعف)([1]).
فالتشابه بين الملاحم قد يعود إلى التعبير عن الأوضاع الاجتماعية المشتركة بين
المجتمعات، وهذه المجتمعات، متشابهة رغم الفوارق العرقية، تتشابه في الجوانب
الانسانية المشتركة، ويمكن ارجاعه إلى مستويات تطورها. (إن الملاحم ظهرت في
مجتمعات مختلفة، دون أن يكون هناك ما يشير إلى أن ذلك قد تم بفعل علاقات التأثير
والتأثر، فقد ظهرت تلك الملاحم في مجتمعات لم تقم بينها علاقات تبادل ثقافي أو
أدبي، لكن على الرغم من ذلك، فإنه من الملاحظ وجود أوجه تشابه كبير بينها، وبما أن
هذا النوع من التشابه لا يمكن أن يرد إلى علاقات التأثير والتأثر (المثاقفة)، فقد
سماه جيرمونسكي تشابهاً نمطياً، والاختلاف في توقيت ظهورها لا يمكن أن يفسر إلا
باختلاف درجات تطور الوعي الاجتماعي. عندما ظهرت تلك الملاحم في الادب اليوناني
القديم، لم تكن المجتمعات الاخرى مهيأة لظهورها، وعندما أفل نجم هذا النوع من
الادب الاغريقي، نشأ وازدهر في بعض الآداب الآسيوية التي لم تقم بينها وبين الأدب
اليوناني أية صلات تاريخية. وهذا ما مكّن جيرمونسكي من أن يُرجع هذه الظاهرة إلى
كون تلك المجتمعات قد بلغت مرحلة التطور الاجتماعي ما جعل ظهور أدب الملاحم
البطولية فيها أمراً ممكناً)([2])،
كالملاحم الاوروبية في القرون الوسطى مثلاً أو في شرق آسيا، أو الملاحم الكردية.
حقيقة الأمر أن ما وصل إلينا من هذا
التراث، يمثل الملاحم الأكثر تسامحاً وشجاعة وأصالة ونبلاً وملاءمة وقبولاً في
المجتمع الجديد متماشياً مع الواقع، فاختارت المخيلة الكردية بعض الملاحم المغناة
التي تلقى الحضور المميز لدى المجتمع ومستمعيه، والتي تحتوي على مواضيع إنسانية
خالدة لإظهار مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية والمعرفية خاصة بعد انتشار
الإسلام، وتجاهل العديد منها بما لا يتوافق مع ظروف المجتمع، فاستمرت هذه الملاحم
في أداء وظيفتها، وحافظت على شخصية الكردي وهويته المتحولة، متجاهلةً التأثير
الاسلامي أحياناً، وأكثر الأحيان متماهية معه مفتخرة بتعاليم الاسلام كعقيدة دينية
تساهم في بناء الشخصية الكردية.
هناك ملاحم تحورت عبر انتقالها من
مجتمع إلى آخر خلال الحقب التاريخية الموغلة في القدم، مثل ملحمة جلجامش. ثمة
علاقة تقاطع وتشابه فيما بين الملاحم الكردية وبين ملاحم الشعوب التي تجاورت مع
الكرد أو تناسجت معها في الثقافة والفكر منذ قديم الأزمان (هل كان التجاور سبباً
في تقاطع الملاحم أم ثمة جوانب أخرى كان سبباً في ذلك؟).
إذا كانت علاقة التقاطع والتشابه
والتماثل، هي علاقة تعبيرية عن إنسانية الفن، فهذه العلاقة لا يمكن القول عنها
إنها علاقة تطابق تبعاً للمواضيع المتضمنة فيها، ولتمثّل الشخصيات التي خضعت
للكثير من التحوّلات والتبدلات تلبية لمتطلبات شعوبها وطبائعهم وميولهم ورؤيتهم
للحياة، ربما لتبيان الكثير من التفاصيل التي تعرضت للتغييرات المرافقة للتطور
الديني والاجتماعي والمعرفي، ولابد من علاقة ما لمشكلة التشابه والتماثل بين هذه
الملاحم، بمعنى كيف يمكن تفسير ظواهر التماثل والتشابه بين الملاحم التي لم تقم
بينها علاقات التواصل المادي والمعنوي؟ لا يمكن قبول البرهنة التاريخية على وجود
أي احتكاك بين هذه الشعوب وثقافاتها.
الاختلاف الثقافي لا يعني أن ثقافة ما
هي أرقى وأنضج فكرياً وجمالياً، أو أقدم تاريخياً أو أكثر غنىً وتنوعاً من ثقافة
أخرى، إن لكل مجتمع نمطاً من الحياة التي تنتج ثقافة، وهذا يعتمد على درجة تطور
الوعي الانساني، لذلك يتوجب على كل الشعوب أن تنظر باحترام إلى فنون وتراث بعضها
دون تحيز للتراث والفن، (إن ما نميز بعضنا هو نوعية العناصر التي دخلت في تكويننا
الثقافي وعددها ودرجة انصهارها وتجانسها وترتيب هذه العناصر هو ترتيب قد يختلف من
عصر إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد)([3])،
بالتالي فالفئات الاجتماعية الأكثر استجابة لهذه الحاجة الانسانية هي فئة
الكوسموبوليتيين الذين يحتوون العالم.
هذا التراث الشفهي الذي وصل إلى الآن
بكل سلبياته وايجابياته عبر الرواة وحناجر المغنين، وما حفظته الذاكرة للأجيال بكل
مقوماتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعقائدية والدينية، أبدعته
الذات الجماعية الكردية مجتمعة، واجه في أحقاب سابقة، ولا زال يواجه، كينونتها
المهددة بالسرقة والتلصص والتشظي والتلاشي والانقراض المطروحة خارج دائرة التاريخ
المدوّن في محاولة لتشكيل الهوية الاثنية الكردية بالمعنى الروحي والثقافي
والقومي، المتمايزة عبر تفكيك الأنساق الفكرية باعتبارها محيط ثقافي وليس عالماً
طبيعياً، يمثل هذا التراث الشفهي البعد الوجودي للذات الإنسانية الكردية المنفتحة
على مر تاريخها للأخر، متمثلة بالذاكرة الحية التي تبث الروح والحركة في جسد
النصوص الشفهية التراثية وتدفعها للعيش، من الملاحم والحكايات والأغاني الآيلة إلى
السقوط في ذاكرة النسيان.
في هذا السياق لا يمكن الحديث عن هذه
العلاقة مع التراث إلا من خلال عمليات التفاعل والتناسج والتناسخ (التناسخ)([4])
كنقطة البحث في النظر إلى الملاحم المتقاطعة والمتشابهة، وهي مرتبطة بقيمة الوجود
الانساني وبحقيقته وعناصره ومكوناته وما يجب فعله في تلك اللحظة التاريخية.
تحمل الصورة الملحمية بين طياتها بعض
ملامح الأصالة، أصالة النص الشفهي الأول، هي ظلال تكيفت في واقعها الجديد فولدت
طابعاً كردياً يمكن تسميته طابع الشخصية الكردية وليست الشخصية المستمدة منها
الملحمة، وامتدت باتجاه المستقبل.
لماذا تظهر شخصيات مثل دون كيشوت أو
هاملت أو أوديب في كل عصر؟ ولماذا نستمتع بسماع دوريش عفدي في كل مرحلة، ونعيد
إنتاج سيامند وخجة في كل منطقة، ونتعاطف مع ممى آلان وزمبيل فروش؟ أليست الإنسانية
بحاجة إلى دون كيشوت جديد عندما ينتشر الشرور والمفاسد، ألا يبعث فينا دوريش عفدي
روح الدفاع كلما حلت بنا الهزائم؟، المغني يحلم، كما الدونكيشوتية خياراً وطريقاً
فردياً، أيضاً يحلم.
يتأكد الأخوان (أوسو وعزيز)([5])
في ملحمة كردية بنفس العنوان، بأن عمهما هو قاتل والدهما، فيقتحمان بوابة المدينة
بسيفيهما بوصفهما ينتميان إلى القروسطية الكردية بعكس هاملت الذي يمثّل النهضة
الاوروبية، فيتردد كثيراً للأخذ بالثأر، ولا يختلف النموذجان عن ثأر الزير سالم في
التراث العربي.
يقف الباحث مندهشاً حيال قصة (ممى
وزينى) في ملحمة (ممى آلان) الشفهية التي تتقاطع مع قصة (روميو وجولييت) في
المسرحية بالعنوان نفسه لشكسبير في الموضوع وفي الشخصيات، في مشهد الشرفة في الحكايتين،
وكذلك في تشابه موقف اياغو في المسرحية مع موقف (بكو عوان/ بكو الفساد) في (ممى
آلان) لدرجة مذهلة.
ألم ترتفع خيانة محمود ملكاني في ملحمة
(قلعة دمدم)، إلى مستوى خيانة افيالتس في (أسطورة 300 فارس) لعبور جيش الفرس إلى
خلف الخطوط أيضاً؟ هل سألنا أنفسنا مرة، لماذا خان محمود ملكاني؟ ولماذا يقوم
المرء بفعل الوشاية؟، هل كان إياغو كان واشياً أم محباً غيوراً؟.
في هذا السياق، هل يمكن القول إن شخصية
راسكولينكوف في رواية (الجريمة والعقاب) لديستوفسكي التي قتلت المرأة لإنقاذ
العالم من شرورها جزء من تلك الشخصيات الساعية الى انقاذ العالم من الشرور؟. وتذكرنا
هذه الشخصية بموقف دوريش عفدي الذي لايتوانى للدفاع عن التحالف الملي ضد هجوم
الترك والغيس حتى لو كان وحيداً، وحتى لو كان الترك والغيس يملكون جحافل كبيرة من
القوى الشريرة، سيحاربهم، لتعيش الملية في رخاء. لا يقل هذا الموقف أهمية عن موقف
جلجامش الذي راح يبحث عن نبتة الخلود بعد موت صديقه انكيدو لإنقاذ البشرية. لقد
وقع الظلم على الشعوب، ويجب (انقاذ العالم من الشرور)، فاختلفت القوى التي تسعى
للقضاء عليها والأساليب المستخدمة من أجلها.
تتقاطع (دوريش عفدي) مع الملاحم الاخرى
في بعض ملامحها، وتختلف عنها في بعضها الاخرى، لكن النتيجة متشابهة فيما بينها إلى
حد ما حتى إن كانت اللغة واحدة (الكردية كمثال) في ملحمتي (كلكى سليمان) و(دوريش
عفدي) من التراث الشفهي الكردي، الملحمتان أُنتجتا لعشيرة الملية ضد عشيرة الغيس
العربية، وانتشرتا بين العشائر الاخرى، تتشابهان من حيث موضوعها وحبكتها وبنيتها
ونموذجها وسياق الاحداث فيها، والأهم تشابه وظائف الشخصيات الرئيسية، وعنصر الشرط
(شرب القهوة) والصراع بين العشائر، مجموعة فرسان يواجه جيشاً جراراً في الملحمتين (دوريش
ايزيدي، كلكى سليمان ليس ايزيدياً، لكنه يؤمن بالمعتقدات الايزيدية)([6])،
وموت الفارس في الملحمتين، والذي يحفّز المستمع للمتابعة.
هل ميديا كانت قاتلة، وهل ياسون خائن
العهد؟ (ميديا… ياسون) ثنائية متناقضة في كل شيء، نعمة الامومة تقابل شهوة
الانتقام. الحب مقابل الخيانة. هل هي تجسيد للصراع بين الرجل والمرأة في مفهوم النسق
النسوي، أم صراع بين الشرق والغرب بالمفهوم السياسي؟، هل تنتصر إرادة المرأة في
الصراع؟. هل هي هزيمة الحضارة الغربية؟ أمازالت انتيغون تبحث في المقتلة السورية
عن الخائن أم تبحث عمن يحتاج إلى الدفن؟ ماذا سيفعل العالم إن عرف من هو الخائن،
القاتل أم المقتول؟.
يدور حوار فلسفي حول الحياة والموت
والحساب بين الانسان والجمجمة، في ملحمة (جمجمى سلطان) الايزيدية، وبمحو الصدفة
كانت الجمجمة على قارعة الطريق، يلتقطها الانسان زيبث فيها مونولوجه الدرامي، هي
أقرب إلى مونودراما، كما يفتح حفار القبور حواراً ساخراً مع الجمجمة في مسرحية
(هاملت) لشكسبير.
نحن كبشر، تتضخم فينا سيكولوجية
المبالغة، لدرجة أننا نبالغ في كل شيء، ونصدق ما نبالغ فيه على أنه حقيقة غير
قابلة للنقاش، كوننا عاطفيون وحالمون وليس لنا علم بحقيقة الشيء المبالغ فيه،
نبالغ في حبنا للرموز الوطنية والدينية والقومية وقدرتهم وقوتهم دون الشك في نزاهتهم،
نبالغ في الكذب وفي الصدق وفي التطرف، ومن نافل القول أن نكون بارعين في مبالغة
الشخصيات التاريخية والتراثية إلى حد الاحترام والتبجيل والقداسة، كما نفعل ذلك مع
الشخصيات الدينية، أحياناً تهرباً من الواقع، وأخرى تحريضاً لذاكرة المستمع لصناعة
الرموز التاريخية والاقتضاء بهم، خاصة في الأدب والفنون والغناء الملحمي، وكل ما
يتعلق بإنتاج الخيال، هذه المبالغة يرغبها المؤدي ويستمتع بها المستمع، فالشخصية
العظيمة تحاك حولها الحكايات والقصص والأساطير التي تمجد قوتها وشجاعتها وتصرفاتها
وسلوكها، أليست العظمة من نصيب زعمائنا الدينيين والسياسيين؟.
ألهذه الدرجة كانت الحياة قاسية، أم
أننا نحن أصحاب القلوب الحجرية نتقبل القسوة كشكل فيزيولوجي، فلماذا ألصقت القسوة
بحياتنا كي نمارسها على أنفسنا بل أكثر من ذلك؟ ما الذي يجعلنا نصدق ما يقوله
الاقدمون؟ رغم ذلك نصدق كل ما قيل عن التراث الاسطوري والملحمي، تاريخاً
وفلكلوراً، نقتنع به كواقعة تاريخية أم كواقعة فنية حدثت بالقوة؟ ألم تكتمل
المأساة بموت الأبطال، إما بيد الأعداء أو بيد القدر؟.
هل كان من الحصافة أن ينتظر التراث
الكردي، زواراً، أو مبشرين، أو مستشرقين غربيين لجمع الملاحم والحكايات الشفهية
وتوثيقه وأرشفته؟ لماذا توجب على المثقف الكردي الدخول في سبات عميق قرابة قرن
ونصف قرن من الزمن، لترتفع الأصوات بعدها بأهمية التراث والفلكلور وتحديد هويته
الممزقة؟، أين كان المثقف الكردي؟ وبأي شيء كان منشغلاً؟. إن الذات الكردية التي
بدأت بالتنبه إلى ذاتيه الكتابة، كانت تواجه دائماً بالقمع والاقصاء تحت ضغط
الظروف بكل ما أسسته من نظم اجتماعية ودينية رسخت فيها الايمان بالقدرية، وهي فكرة
قديمة غلبت على عقلية الشرقيين عموماً بسبب الاوضاع التي كانت سائدة.
[1]ـ أحمد مدثر، المثقف في
الأقطار الناشئة، فكر وفن العدد1. معهد غونه، عام 1963، ص14
[2]ـ عبده عبود، الادب المقارن، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،1999، ص 44
[3]ـ نهاد صليحة، المسرح بين الفن والحياة، الهيئة العامة للكتاب،
القاهرة، 2000، ص39.
[4]ـ
التناسخ للأرواح، وظهور شخصيات قديمة في أدوار
حياتية جديدة، يتقمصون كثيرون في التراث وفي الواقع شخصية بكو عوان، قد تظهر هكذا
شخصيات في الملاحم والحكايات اللاحقة، وليس غريباً أن تتشابه صفات الشخصيات ووظائفها
ومواقفها، وإن اختلفت الفترة الزمنية والفسحة المكانية.
[5]ـ تدور ملحمة (اوسو وعزيز) حول قصة أمير بوطان يدعى خالد بك، لديه
طفلان وابنة بالغة تدعى (قدرة)، تكتشف الابنة أن والدتها (آزيرة خاتون) على علاقة
غير شرعية مع عمها (اسكان بك)، تدرك الام أن ابنتها كشفت أمرها، فتحضر سماً وتدسه
في قهوة الصباح تقدمها لخالد بك قبل صلاة الفجر.
[6]ـ فلاديمير بروب، فورمولوجيا الحكاية،، ط1، ترجمة عبد الكريم حسن
وسميرة بن عمو، دار النشر الشراع، دمشق، سورية، 1996. ص35.
* عبد الناصر حسو (حسين): مترجم كاتب وناقد مسرحي، تولد عفرين/ قرية عشقيبار.
تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية- دمشق ودرّس فيها لاحقاً.
أمين تحرير مجلة الحياة المسرحية سابقاً
من أعماله: كتاب الإيزيدية وفلسفة الدائرة، ممي آلان – ترجمة.
ملحمة درويشي عڤدي المغناة- دراسة.
وُثق ونُشِر له ١١ مجلداً حول المسرح السوري .