الكُرد في اليمن _ في العصور الساسانية والإسلامية والأيوبية والرسوليّة.
-الجزء الأول- لهنك إبراهيم *
اليمن ذاك البلد الجبليّ، يسكنه شعبٌ، لطالما عُرف بالطيبة والبساطة، شعبٌ وجد نفسهُ داخل صراعاتٍ مذهبية دينية، وإيديولوجياتٍ سياسية حتى الوقت الحاضر.
كان اليمن في فترة ما قبل الفتح الإسلامي، مشتّتاً بين عدّة قبائل ودويلات و إمبراطوريات كبرى، حيث كانت هناك قبيلة حِمْيَر، وكِنْدَة في حضرموت، وهمدان، وكانت صنعاء وعدن وما حولهما تابعة للحكم الساسانيين الكُرد -صحيح أنّ الساسانيين ينحدرون من أسرة كُردية الأصل، لكن الدولة كانت باسم الفرس، د. أحمد خليل -، وكانت نصارى نجران تابعة للحكم الروماني.
وعن الساسانيين، حاول العديد من الباحثين والمؤرخين الكُرد ك/د. أحمد خليل، ود.مهدي كاكائي وغيرهم/ من غير الكُرد، البحث في نسبهم الكُردي الأصل؛ استناداً على مصادر ومراجع إسلامية وأجنبية عدّة.
يعدُّ الملك أردشير الأول مؤسس الإمبراطورية الساسانية، ويرجع نسبه إلى أردشير بن بابك بن ساسان(1)، وساسان هذا كان كاهناً زرداشتياً على بيت نار أصطخر (بين نار أناهيذ) حيث كان شجاعاََ شديد البطش، وزوجته رامبَهشت ذاتُ جمالٍ وكمال، كانت من قومٍ من الملوك يعرفون بالبازرنجين (بازرنگي).[الطبري، ج 2،ص 37،38].
أخذ اردشير حكم أصطخر من أخيه سابور ثأراً في سنة 208 م، وبدأ فيما بعد بالتوسع في أراضي الإمبراطورية الپارثية “الفرثية” الإشكانية، وهذا ما أثار الغضب لدى آخر ملوكها كان اسمه أردوان الخامس، فأرسل إلى أردشير مكتوباً يحذره من أفعاله، كما وفي الرسالة تأكيدٌ لكُردية الأسرة الساسانية والتي ذكرها الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك، حيث جاء في الرسالة:
“إنك عدوت طورك، واجتلبت حتفك، أيها الكردي المربى في خيام الأكراد! من أذن لك في التاج الذي لبسته، والبلاد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهلها، ومن أمرك ببناء المدينة التي أسستها في صحراء – يريد جور-” فيردّ عليه أردشير : “إن الله حباني بالتاج الذي لبسته، وملكني البلاد التي افتتحتها، وأعانني على من قتلت من الجبابرة والملوك، وأما المدينة التي أبنيها وأسميها رام أردشير، فأنا أرجو أن أمكن منك، فأبعث برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أسسته في أردشير خرة.” [الطبري، ج 2،ص 39،ص40]
بعد هزيمة جيش أردوان الفارسي على يد أردشير الكُردي، قتله أردشير ومنذ ذلك الوقت سمي باردشير الشاهنشاه أي ملك الملوك وبدأ بالتوسع شرقاََ وغرباََ وشمالاََ وجنوباََ.
في الثلث الأخير من القرن السادس عشر غضب أحد أمراء اليمن سيف بن ذي يزت؛ من خضوع البلاد تحت سيطرة الأحباش المسيحيين، فطلب المساعدة من إمبراطور بيزنطة (جستين الثاني) إلا أنه رفض لأن الأحباش على نفس دينه، فذهب إلى الإمبراطور الساساني أنو شيروان (2)، فأرسل انوشيروان معه وهرز “بهريز” (3)، وأبنه نوزاد على رأس قوة استكشافية تدعى أسواران (4) وكانوا غالبيتهم محاربين من الديلم وجوارها – والديلم هم قوم من أصل كُردي [المنجد العربي ،ط 21،دار المشرق، 1973م]، وأيضاً ذكر اسمهم في المعجم الوسيط ( الدَّيْلَمُ ): جيل من العجم كانوا يسكنون نواحي أَذربيجانَ [المعجم الوسيط] ، أما الحُميري فيذكر اسم مدينة الكلار في باب الكاف من كتابه، بأنّها مدينة من مدن طبرستان، وبها أكراد الديلم وهم أهل الفروسية والنجدة [ الحميري، ج 1، باب الكاف الكلار] – فقاتلوا الأحباش مع حلفاء سيف بن ذي يزن الحميري، وطردوهم من اليمن ونُصبَ سيف بن ذي يزن ملكاََ عليها كشخص تابع للإمبراطورية الساسانية.
بعدها عاد وهرز إلى الدولة الساسانية في 575 م ، ولكن الأثيوبيون قتلوا الملك سيف بن ذي يزن مما اضطر وهرز إلى العودة على رأس قوةٍ قوامها 4000 رجل، فطرد الإثيوبيين منها، وأصبح صاحب وملك اليمن و تشكلت في تلك فترة حامية ساسانية كبيرة في اليمن ويعرفون الآن باسم آل الأبناء نتيجة تزاوج الجنود الساسانيين مع السكان المحليين.
بعد قتل وهرز على يد الأثيوبيين ، نُصب مكانه مزربان واستمر الحكم الساساني في اليمن إلى أن أتى باذان الذي عُيّن حاكماََ على عدن وصنعاء وضواحيها بأمر من أنوشروان ويعد آخر حاكم لليمن الساسانية الذي يلعن إسلامه في 627م بعد ذلك بدأت ظهور دعوة رسول الإسلام محمد (ص)، والذي عينه واليّاََ مسلماً على تلك المنطقة حتى وفاته. [ابن حجر العسقلاني، ج 1،ص 464].
بعد ظهور الأسود العنسي (5) والذي بدأ بنشر دينه،حيث أقنع قومه بأن الوحي أتاه، فسار إلى صنعاء فخرج إليه شهر بن باذان ملك اليمن وتقاتلا، فغلبه الأسود العنسي وقتله بعد كسر جيشه الذي تشكّل من أبناء (ساسانيّ وديليميّ اليمن الذين تزوجوا من اليمن) وتزوج من امرأته ، والتي كانت ساسانية الأصل امرأة حسناء جميلة واسمها آزاد، وأصبحت أغلب مناطق اليمن تحت حكم الأسود العنسي لمدة 25 يوماََ فقط، وارتد خلق كثير من اليمن، فأسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي (6)وداذويه، وفيروز هذا يكون هو ابن عم آزاد زوجة بازان بن ساسان، فاتفق فيروز مع بنت عمه آزاد بعد أن ساءت علاقته بالعنسبي، على قتل الأسود العنسي فسقته الخمر حتى نام، ودخل فيروز وقتل الأسود العنسي .[ابن كثير، ج 6،خروج الأسود العنسبي، ص 430].
وبعدها عاشت اليمن حياة احتدامٍ وصراع بين قبائلها خلال العهدين الأموي والعباسي، حيث حكمها بنو زياد (819- 1019)، و بنو نجاح (1022 – 1158) وبنو صليح الإسماعيليون (1047 – 1138)، بعد سقوط الأخير انقسمت البلاد إلى خمس سلالات متنازعة قضت عليها الدولة الأيوبية في عام 1174م.
بدأ الوجود الكُردي الثاني في اليمن أرضِ التُهامة في العهد الأيوبي والدولة الأيوبية التي امتدت حتى عدن ومناطق من سلطنة عمان جنوباََ، كانت اليمن تعيش حالة صراع بين الدويلات الإسماعيلية الشيعية قبل مجيء الأيوبيين، حيث يرجع ابن شداد سبب فتح الأيوبيين لليمن إلى ماكان من قوة عسكر صلاح الدين وكثرة إخوته وقوة بأسهم، ومابلغه من أمر ابن مهدي وتغلبه على الكثير من بلاد اليمن، وإقامته الخطبة لنفسه دون بني العباس وزعمه انتشار ملكه حتى يملك الأرض كلها دون بني العباس، وهذا ماأثار تخوّف الأيوبيين وجعلهم يفكرون بحملة للسيطرة على اليمن.
تأسست الدولة الأيوبية في مصر بالسيطرة على الدولة الفاطمية، ويبدو إن النفوذ الشيعي في عدن وصنعاء اليمنية ودولة بني مهدي الخارجي في الزبيد قد أثار مخاوف لدى الأيوبيين، فقد جهز صلاح الدين الأيوبي الكُردي أخاه تورانشاه للقيام بحملة اليمن في 1174، وقد تحمّس تورانشاه لهذه المهمة وزوده صلاح الدين بالعسكر والذي قدّر عددهم حوالي ثلاثة آلاف وألف فارس وجماعة من الأمراء (الذين كان معظمهم من الكُرد).
سيطر جيش تورانشاه على حرض في منطقة جازان السعودية والتي كانت تحت سيطرة الأشراف السليمانيين دون حرب، وبعدها قضى على دولة بني مهدي في الزبيد والجند وتعز، وفيما بعد سيطر على دولة بني زريع الإسماعيلية في عدن، ولم يمضِ وقت طويل حتى سيطر على دولة بني حاتم الهمْدانية صنعاء، وسيطر على حضر موت دون قتال، وأناب عنه بها رجلاََ كُردياََ يدعى هارون [أبي الشامة، ج 1، ص 260].
وبذلك أنهى تورانشاه فتح اليمن بعد فتحه ثمانين حصناََ ومدينةً تركها فيما بعد ليتولى نوابه من بعده، الذين بدأوا باستغلال الحكم في الحصون وباتوا يحاولون الخروج عن طاعة الأيوبيين،إلا إن إرسال صلاح الدين حملة تأديبية بقيادة صارم الدين خطلبا قد أعاد الاستقرار في اليمن.
استلم الحكم من بعد تورانشاه أخاه طغتكين، وبعد وفاته استلم الحكم ابنه معز الدين إسماعيل، حاولت بعض الإمارات الاستقلال في عهده ، كبني حاتم الذين أيدوا الإمام عبد الله بن حمزة بإعلان الإمارة، لكن القوات الأيوبية بقيادة الشهاب الجزري نائب صنعاء وسيف الدين حكّو بن محمد الكُردي(7) ، استطاعت رده وفرقت عسكره عندما حاولوا التقدم إلى حصن بيت خولان /من أعمال ذمار/ [ يحيى بن الحسين، ص 85].
سياسة معز الهوجاء وبطشه بقيادة جيشه، أدتْ إلى دبِّ الخلاف بين سيف الدين حكّو بن محمد الكُردي والشهاب الجزري، فاستمال سيف الدين حكو إلى جانب دعوة الإمام عبد الله بن حمزة والذي بدوره منحه الحماية ليستعين به في ضرب القوات الأيوبية، فبايع حكّو الإمام وأظهر الطاعة له بدلاََ من معز الدين اسماعيل بن طغتكين، ولم يمض وقتاََ طويلاً حتى ألحق به أحد مقدمي جيش المعز يدعى هشام الكُردي [يحيى بن الحسين، ص 85]،وبذلك استطاع الإمام السيطرة على صنعاء بمساعدة قادة الأيوبيين من الكُرد – حكّو وهشام وشمس الخواص-، لكن بعد قضاء المعز على القادة المنشقين الذين سيطروا على مناطق واسعة من المناطق اليمنيه، تدهور موقف الإمام عبدالله بن الحمزة وامتد الانقسام إلى صفوف الأشراف الزيدية أنفسهم، حيث أعلن بنو سليمان موالاتهم للمعز، حاول الإمام العودة إلى اسلوبه الأخير في استمالة القادة الأيوبيين فاستطاع استمالة قائد أيوبي يدعى هلدري بن أحمد المرواني، وبعده علم الدين وردسار(8) وسيف الدين سنقر، حتى أن ادّعى معز اسماعيل الخلافة و الانتساب لبني أمية وهذا مايخالف نسبه الكُردي الأصلي، فاتفق جنده على التخلص منه حيث يقول السكبسي في هذا الشأن “وكان راكباََ-يُقصد بمعز – على بغلة، وعليه حلة طويلة الأكمام فوثب عليها الأكراد عند مسجد شاشة – يقع مسجد شاشة على بعد ميلين إلى الشمال من زبيد – فقاتلهم بالمقرعة، ودعا بحصانه، فحال الأكراد بينه وبين جواده، واستل سيفه فحالت أكمامه الطويلة بينه وبين الضرب بالسيف، فقتل وقتل معه مملوكه، ومثلوا به” [الكبسي، ص33 أ]، ونُصب أخاه الناصر أيوب بن طغتكين خلفاََ له وهو لا يزال طفلاََ في العاشرة من عمره، وعُين الأمير سيف الدين سنقر (مملوك والده) أتابكاً، بعد وفاة آخر ملوك الأيوبيين المسعود صلاح الدين يوسف بن طغتكين في 1228م تاركاََ الحكم إلى نائبه نور الدين عمر بن رسول، وبدوره بدأ الحكم الرسولي وإزالة الحكم الأيوبي، وما إن حلّ عام 1230 م حتى أعلن عن قيام الدولة الرسولية ولقب نفسه بالملك المنصور واستمر حكم هذه الدولة حتى عام 1454 م، وبذلك نرى بأن الكُرد كانوا عمود الدولتين الأيوبية والرسولية وبرز دورهم في حكم الدولة وازدهارها العمراني والحضاري في المدن اليمنية وهذا مايؤكدّه الكاتب اليمني د. عبد الودود مقشر.
حيث برز من الكُرد في الدولة الرسولية بنو فيروز (9) وهم من أمراء العهد المنصوري والمظفري والمؤيدي،وهم أصحاب إب من ذرّية الأمير فيروز من الامراء بنو فيروز في عهد الدولة الرسولية ويقال أنهم كانوا أمراء إب قبل أيام الملك المنصور، بعد اغتيال الملك المنصور نور الدين عمر بن رسول على يد نفر من مماليكه بمساعدة ابن اخيه أسد الدين اجتمع بنو فيروز و حملوا السلطان ي محمل وقصدوا به تعز فدفنوه في المدرسة الأتابكية، ولولا عزمهم وتشميرهم لم يجسر أحداََ على ذلك فكان المظفر بن المنصور (الذي ولى الحكم من بعده) يعرف ذلك لهم ويشكرهم على مافعلوه ،فاقطع لأبي بكر الملقب بشمس الدين طبلخانة ولاخيه عثمان الملقب فخر الدين الإقطاعات الجليلة [الخزرجي، ج1 ،ص 83 ص 84]،وقال عنهم الأهدل في تاريخه بنو فيروز : قوم من الأكراد تدبروا في مدينة إب منذ زمن طويل و يغلب عليهم الخير، وقومهم أهل فراسة و شجاعة [محمد يحيى الحداد، ص 120].ومنهم حسن بن أبي بكر فيروز الذي ابتنى مدرسة حسن، وابتنى من بعده أبناؤه العديد من المدارس، ولهم بقية اليوم في مدينة إب وجبل حبيش والذين في بعدان منهم واوقافهم بوادي الظهار بإب، وبرز منهم علماء وصلحاء و مدارسهم مازالت عامرة في قلب مدينة إب. [الجندي، صج 2، ص164-165].
بعد ضعف الدولة الرسولية استقر غالبية أمراء الكُرد الأيوبيين ومماليكهم في ذمار، وصاروا صُناع أحداث داخل دولة الإمامة الزيدية نفسها(10)، حيث استطاع المهدي علي بن محمد بمساعدة هؤلاء الأمراء من إنهاء سيطرة الرسوليين في معظم اليمن الشمالي وحارب الإسماعيليين و استولى على صنعاء في 1323م، زوَج ولده الناصر صلاح الدين بن محمد من فاطمة بنت الأسد الكُردي، واستطاع بمساعدة والدها تثبيت أركان دولته، بعد أن جعله والياََ على ذمار، وكانت نتيجة تلك المصاهرة حفيده علي، الذي تولى الإمامة بعد وفاته.
عند تولي الإمام علي بن الناصر صلاح الدين كان عمره آنذاك 18 عاماً، ولُقب ب المنصور والذي استعان بقوة والدته وأخواله الكُرد ومماليكهم عندما عارضه بعض علماء الزيديين بمبايعتهم لأحمد بن يحي الذي لقب نفسه بالمهدي، كان عهده أقرب إلى الملك، لأسباب عدة، أبرزها أنّه لم يكن مستوفٍ لشروط الإمامة، كما كان لأمه الكُردية ولمماليك جده ووالده دور بارز في ذلك التحول، كانت أمه قوية مهابة، أدارت الحكم أثناء غيابه عن صنعاء باقتدار وهذا مايظهر قدرة المرأة في كنف الدولة الأيوبية والتي كانت تلقب بالخاتون على إدارة الحكم، حيث كانت تباشر بنفسها تجهيز الحملات العسكرية إلى المناطق المضطربة القريبة والبعيدة عن ذات المدينة.
بقيت علاقة المنصور بالرسوليين حكّام المنطقة بعد الأيوبيين هادئة و مستقرة، وكانت الدولة الزيدية أشبه بمنطقة حكم ذاتية، على الرغم من محاولات الرسوليين الفاشلة بالسيطرة عليها، وأيضاً الزيديين الذين أيدوا الهادي علي بن المؤيد الذي أعلن نفسه إماماََ في شمال الشمال، وانتهى حكم الرسوليين على يد الطاهريين الذين حصلوا على دعم مماليك مصر.
الهوامش:
(1) وإليه تنسب الدولة الساسانية، وساسان هذا قد نُسب إلى ساسان ابن إسفنديار، حيث أنه لما حضرت أباه المنية فوّض أمر الحكم إلى ابنته، واشترى لنفسه غنماً وجعل يرعاها، وعُيّر بأنّه راعي الغنم، فقيل ساسان الراعي، وساسان الكُردِي، وقيل أيضاً أنّه كان ملكاََ من ملوك العجم حاربه دارا ملك الفرس، ونهب كل ماكان له. [أحمد أمين، ظُهر الإسلام، المجلد 1،ص 157]،وينسبهم الباحث الكُردي مهدي كاكائي إلى عشيرة شوانكاره “. كان (ساسان) ينتمي الى العشيرة الكوردية (شوانكاره) الكُردية اللذين كانوا يشتغلون في الرعي و الزراعة وفي أواخر عهد البويهيين قاموا بتأسيس سُلالة كوردية حاكِمة باسم (أتابكة ملوك شوانكاره الكورد في فارس) [ابن البلخي، فصل احوال شبانكاره و كُرد و فارس. طبع اوروپا، ص 150 – 153.]،وباستناده إلى مصدر آخر يظهر بأنّ أفراد عشيرة (شوانكاره) ينحدرون من (أردشير بن بابك مؤسس الدولة الساسانية)[إدوارد ڤون زامباور، ص 351 – 352.]
(2) أنوشروان (كِسرى أو خِسرو الأول) ملك ساساني عُرف بانشروان العادل انوشيروان دادگر وهو انوشيروان بن قُباد بن يزدجرد بن بهرام نرم (الليّن) .
(3) اسوران قوة من سلاح الفرسان شكلت العمود الفقري في الجيس الساساني.
(4) وهرز أو بَهْريز قائد عسكري ساساني من أصل دليمي كُردي.
(5) وهو عبهلة بن غوث من كهف خبان، وقد أقنع قومه أنه نبي يوحى إليه.
(6) فيروز الديلمي أبو الضحاك ، أمير، صحابي يماني ، ديلمي الأصل وهو من أبناء الديالمة الذين ارسلوا لقتال الحبشيين.
(7) سيف الدين حكو بن محمد الكُردي أحد كبار قادة الأيوبيين، حيث كان معروفاََ بشهامته وقوته وشجاعته في الحروب فكان يؤدي مهمته على أحسن وجه، وهناك من يذكره باسم جكوا.
(8)علم الدين وردسار بن بيامي الكُردي الأمير، كان من أعيان امراء الأكراد ومن المشتهرين بالإحسان الأجواد[مجمع الآداب في معجم الالقاب].
(9) بنو فيروز من أشهر الأسر الكردية التي ذاع صيتها في عصر الدولة الرسولية في اليمن، لمواقفهم السياسية، ولمكانتهم الإجتماعية المرموقة، وقد سكنت هذه الأسرة في مدينة زب وجبل حبيش، واستوطن بعضهم منطقة بعدان.
(10) الزيدية مذهب تعتبر جزءاً من الإسلام الشيعي، لكنه أقرب فقهياََ إلى الإسلام السنّي، والحوثوين زيديون ولكن ليس كل زيدي حوثي، فالحوثية حركة إسلامية سياسية. [BBC عربي].
المصادر:
(المستخدمة الواردة في المقالات المقتبسة أيضاً)
¬ يحيى بن الحسين بن المؤيد اليمني، أنباء الزمن في أخبار اليمن، صححه:محمد عبد الله ماضي، برلين، ڤ.دى غرويتر، 1936م.
¬ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، وضع حواشيه:إبراهيم شمس الدّين، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م،الجزء الثاني.
¬ محمد بن اسماعيل الكبسي، اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، حققه :أبوحسّان خالد أبازيد الأذرعي، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، 2005م.
¬ الطبري، تاريخ الرسل والملوك “تاريخ الطبري”، بيروت، دار الكتب العلمية، الجزء الثاني.
¬ محمد يحيى الحداد، تاريخ اليمن السياسي، القاهرة، دار وهدان للطباعة والنشر، 1968م.
¬ ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، حققه:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية 1995م، الجزء الأول.
¬ أحمد أمين ،ظهر الإسلام،القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،1946م، المجلد الأول.
¬ إدوارد ڤون زامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، إخراج: الدكتور زكي محمد حسن بك و حسن أحمد محمود،الترجمة:د. سيدة إسماعيل كاشف و حافظ أحمد حمدي و أحمد محمود حمدي،بيروت، دار الرائد العربي، 1980 م.
¬ محمد بن عبد المنعم الحِميري، الروض المعطار في خبر الأقطاب، حققّه:د. إحسان عبّاس، بيروت، مطابع هيدلبرغ،الجرء الأول، 1984.
¬ ابن البلخي، فارسنامه، حقّقه وترجمه عن الفارسية:يوسف الهادي، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2001م.
¬ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي “ابن كثير”، البداية والنهاية،دققه:حنّان عبد المنّان، بيروت، بيت الأفكار الدولية، 2004م.
¬ د. محمد عبد العال أحمد، الأيّوبيّون في اليمن،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب- جامعة القاهرة، 1980م.
¬ بلال الطيب، إمامة المماليك والنساء، 2019م،موقع الحرف 28.
¬ علي بن الحسين الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، صححه:محمد بسيوني عسل، الفجالة، مطبعة الهلال، 1911 م، الجزء الأول.
¬ القاضي أبي عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي الكِندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، حققه:محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي، صنعاد، مكتبة الإرشاد، 1995 م.
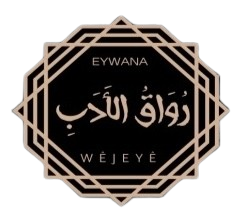






مقالة رائعة