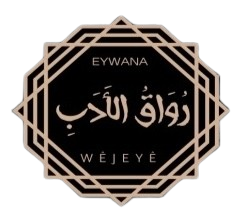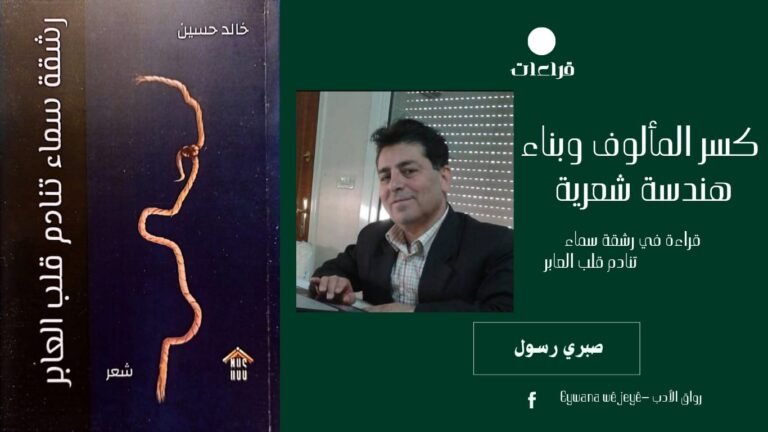–قدّمتها الكاتبة زينب خوجة–
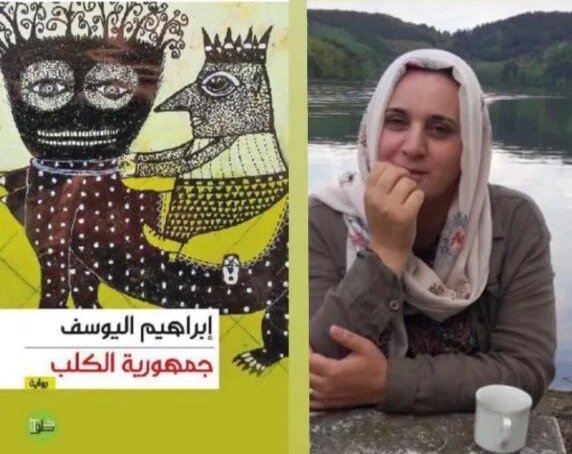
جمهورية الكلب،
إنها جمهورية أن تبقى عالقاً هناك، في وطن حملته معك أينما ارتحلت، لدرجة الاحتفاظ بصوت “كازي” على شريط التسجيل. وإن توقفت الحرب هناك، لا يزال آلان النقشبندي ضائعاً، يغسل يديه مرات عدة كلما لامس فرو جرو، أو حتى شمّ رائحته، متذبذباً لا يبرح يقارن بين الحيوات هنا وهناك، يتناول كل الأمور التي لا تغادر مخيلته مذ كان طفلاً إلى أن ناهز ما يزيد على الخمسين.
متخذاً من شخصية صديقته الألمانية محوراً لروايته، ليعود في كل مرة متناولاً إحدى القضايا التي عاركها وصنعت منه ما هو عليه الآن، آخذاً على عاتقه هواجس الكثير منا كلاجئين طحنتهم الحرب بطريقة أو بأخرى، فدفعوا ضريبتها من جيب حياتهم المكلومة بتفاصيل وقصاصات حكايات لن تروى أبداً.
كما روى الكاتب جانباً من حياته وحياتهم، باختلاف رؤانا ونظرتنا لمسائل جمّة. مرة يتحدث بعفوية عن طبيعية التصرفات في الغرب، كأن تتعرّى له امرأة أربعينية واصفاً إياها بالشفافة والصادقة والطيبة، ثم ينغز خاصرة الشرقيات حسب النظرة المجتمعية الذكورية، في إحصائية صغيرة تختصر النساء في تصرفات فردية: النساء اللواتي تركن أزواجهنّ الذين باعوا الحيلة والفتيلة ليصلوا بهنّ إلى برّ الأمان ليتخلين عنهم في أول فرصة، واللواتي مات عنهنّ أزواجهنّ، فإذا بهنّ لا يكاد ينتظرن شهراً ليتزوجن بغيرهم، ناسين العشرة والخبز والملح. مع أننا نعتقد أن قليلات هنّ من لا يلتزمن بالعدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها.
بهذا نرى إجحاف هذه النظرة غير المكتملة للمرأة التي لم تُسرد حروبها الخاصة؛ لأنها بالفعل صانت العشرة إلى أن بلغ السيل الزبى، وكان لا بد لها من الصراخ وقول “كفى” بعد أن فقدت السند هناك، ووجدت ملاذها في الغرب، محاولة بأقل الخسائر أن تنجو من عنف أصبح عرفاً وأمراً اعتيادياً.
نرى الفرق بين أن يكتب كل طرف نصف الحقيقة: رجالاً ونساء. فإن لم تكن كل النساء بريئات، فليس كل الرجال ملائكة ومظلومين. خاصة عندما يذكر الكاتب تخوّفه من أن تفعل زوجة “آلان” مثل ما فعلت النساء الأخريات، بل يستبعد أن تقوم بذلك، مع أنه تجاوز خطوطاً حمراء كثيرة ربما يراها حرية أو من حقه. ومع ذلك، فالأفضل أن تسكت الزوجة في كل الأحوال فقط لأنه رجل وهي امرأة.
يحاول أن يندمج بإحضار كلب إلى البيت، لكن من المستحيل أن يسمح للنساء أن يندمجن، مثلاً. الكاتب يؤكد على ما عليه كثيرون منا، والتناقض الذي نعيشه في أمور كثيرة، فنكون انتقائيين فيما يناسبنا كشرقيين في بلاد الغرب. والفتاوى التي تتيح ذلك كثيرة، بل إن كثيرين منا فرضوا طقوسهم على المكان الجديد، كالتدخين داخل البيت، مثالاً صغيراً جداً لازدواجية معاييرنا البشرية.
في جمهورية الكلب، ثمّة أرواح قدّر لها أن تسكن أجساداً مختلفة: جسد بشري، جسد حيواني، وجسد نباتي. لا يكاد الكاتب ينسى أن يعرّج على كل تلك الأرواح، يعطيها مساحة لتعبر عن كينونتها ووجودها، هاتفة بلغة أو بأخرى “ها أنا هنا”.
أحداث كثيرة تسلّط الضوء على مواضيع حياتية بكل تناقضاتها: اجتماعية، سياسية، اقتصادية، عسكرية، دينية، ومجمل الموروث الشرقي فيها. الإنسان، الحيوان، والنبات شهود عيان على ماضٍ وحاضرٍ وآتٍ. يثبت فيها الكاتب انتماءه إلى بقعة محددة في جغرافية الكرة الأرضية، لا ينفك يتذكر وصايا البيت الصغير: أبيه، أمه، جيرانه، أصدقاءه، وما مرّ به ذات نهار في فوضى الحياة التي أنتجت شخصيته وصقلتها، ليفهم ما تحدّث عنه في كتابه عن الأوجه الكثيرة للإنسان، والأصابع الألف التي يمكن أن يعدّ عليها كل ما يريد أن يبرّره أو ينكره.
مارّاً بكأس نبيذ، قبلات الرغبة، نجاسة الكلاب، أحقية امتلاكها، موانع هذا الامتلاك، والخوف في بلاده. فكل شيء خائف: المواطن، الوزير، الرئيس، وقبلهم جميعاً الكلب. والخوف الجديد الذي يلبس عباءة الغرب بشعاراته عن الحرية والإنسانية.
الغرب الذي يهزأ بنا باحترام وبالقانون، فينتصر لكلب بدعوى اكتئابه، وهو من يصنع الأسلحة ويرسلها للشرق ليمزّق جسد الوطن مُزعة مُزعة على حسابك أنت كإنسان. وقد لا ينتصر لك في مواقف أنت بأمسّ الحاجة لوقفة وسند في بلاد تزعم الحرية.
فتشبه كثيراً جمهورية العرب التي شعارها “وحدة وحرية واشتراكية”، وجمهورية الكرد التي تنادي بالأخوة وبضرورة الانتصار للقضية، وهي في طريقها لتنتحر القضية.
فتخاف وتشك في حيادية محامٍ كردي علوي أوجلاني، فتفضّل السكوت والصمت على أن تقول بحرية في بلاد الحرية موقفك من تحزّبه وانتمائه. لأنّه باختصار: لا حرية تجدها في طول البلاد وعرضها إلا كما تشتهيها الثقافة السائدة، التي تخيط تلك الحرية على مقاسات مصالح الدول والأفراد.
البلاد الباردة التي تهطل بعناد، ويُطلب منك الاعتياد. وأنت الذي تعرف أن معنى أن تعتاد هو أن تموت أشياء كثيرة في داخلك.
الكاتب يحمل معه ثقافة التراب والماء والأمثال الكردية الكثيرة في جعبة وعيه، ولا يكاد ينسى شخوصه بمختلف انتماءاتهم الطبقية. معطياً الفرصة لكل الكائنات، بما فيها العصافير، الأرانب، الغربان، قطيع الأغنام، وحتى المناخ، فرصة أن تُذكر بين سطوره التي يحاول جاهداً اختصارها، وكأنه عاش أياماً فقط على امتداد سنواته.
معترفاً بأن لا كتب يمكن أن تضم ما عاشه وأقرانه، وآخرون كثر، خاط تفاصيلهم وسردها من خلال زرقة عيني امرأة أربعينية، متحدثاً عن العلاقة الإنسانية المحضة بعيداً عن الحدود التي قسمت هذه الإنسانية وألبستها لبوساً يناسب فصول التصفيات السياسية.
شارحاً بإسهاب معنى أن تكون شرقياً، تغيّر نمط حياتك رغماً عنك، منتظراً أن ينهزم شتاء الوطن ليكون قادراً على العودة. ولا يضطر لحضور حفلة كلاب.
مع أنه، رغم المعلومات المستفيضة التي عرضها عن عالم الكلاب، إلا أنه كلما تعرّف على كلب تأكد اليقين لدى القارئ بأنه يقصد شخصاً ما، لا يسعه ذكر آدميته، فيتحدث عنها على لسان كلب.
والذي يشد القارئ في هذه الرواية، أن كل واحد منا لديه قصة، أو موقف مع إحدى الكلاب: كلب ضال، كلب جار، كلب طريق القرية، قصص الناس من حولنا معها، وحكايا الأمهات شتاءً عن فتاة كانت تبيع الحليب واللبن، فاعترض طريقها كلب القرية في إحدى الصباحات وقطع ثيابها وجعلها مسعورة.
تشبه كثيراً قصة عائلة “فليت”، الأحلام المعتادة التي يرى فيها معظمنا نفسه هارباً من كلب يلاحقه.
ناهيك أنه يلفت نظرنا إلى وجهة نظر الرجال عندما يكونون كتّاباً، والمواضيع التي يتطرقون إليها دون أي خوف. ليس كالمرأة التي تكون حذرة في كل كلمة تتناولها عندما تتحدث عن علاقتها بالرجل، مع أنه نبّه إلى عدم تحرر الرجل من نظرة المجتمع وحكمه، كون إصابته في بيت امرأة تسكن وحدها، وأنه لا بأس أن فعل ذلك سرّاً، المهم أن لا يعلم أحد عن ذلك.
والسؤال الذي بقي عالقاً في ذهني كقارئة للرواية:
وماذا بالنسبة للزوجات والأبناء؟
ففي الوقت الذي كاد أن يفشل في الاندماج، هل اندمجت الزوجة فترضى أن يكون زوجها عند أخرى؟
أم لأنّها أوروبية فلا بأس!
وكذلك بالنسبة للأبناء:
هل بالفعل هناك امرأة تستقبل زوجها بعد ليلة ساخنة له مع إحداهنّ؟ وإن ادّعى أنّها أمور شخصية ولم يمارس تلك العلاقة لدى استجوابه؟
بالطبع، لو كان يتقن اللغة، ولو لم يكن مضطراً لأن يتواجد مع كردي وعربي سوداني، لربما فضفض للبوليس الألماني عن أشياء أخرى. لكنّه، كما ذكرت آنفًا، لا يزال محمّلاً بالخوف من نظرة الآخر القادم مثله من ثقافة الشرق، واعترافه بصعوبة الحفاظ على الأسرة، خاصة مع الجيل الجديد متمثّلاً بابنه الصغير الذي تشرّب الثقافة الألمانية. وغداً، يواجه الابن والده دون أن يكون الأب قادراً على ردعه وتوبيخه كما اعتاد هناك، وكما تمّ تلقينه المحرمات والمحظورات.
فرغم كلّ محاولاته ليكون بعيداً عن الدين، إلا أنّه يعود مكبّلاً ومعترفاً بالوازع والرادع الديني لديه.
ولم ينسَ الحديث عن الثورة السورية، والقتلة من الجانبين، النظام والمعارضة.
كما تناول أعياد المهجر، التي تحدّث عنها بطريقة جعلتك ترسم صورة للاحتفال الذي حضره مع صديقته، والأجواء التي عاشها.
ناهيك عن أنّ “جمهورية الكلب” تذكّرنا كيف أنّنا، بعدما شاهدنا كلاب الغرب، قارنّا بينها وبين كلابنا؛ كلاب العالم الثالث. استغلال الإنسان لها واستخدامه الكلاب في كلّ جوانب حياته. فثمّة كلاب بوليسية، كلاب مرعى، كلاب شرسة مسعورة، وكلاب قاتلة مدرّبة على نهش أجساد المعتقلين.
العنف الممارَس ضدّ الكلاب حسب ثقافة الشعوب وتأثر الكلاب بما يحدث في عالم الإنسان، هذا الحيوان الناطق الواعي لأفعاله.
كما تحدّث عن أساليب تعذيب الكلاب بين الشرق والغرب، حيث لا فرق بين من فجّر الكلاب لأغراض عسكرية وبين الأطفال والآباء الذين أنهوا حياة الكلاب برصاصة أو بالحرق.
الإثارة الحقيقية في الرواية جاءت من خلال سرّ مجيء الكلب إلى بيت آلان النقشبندي واختفاء بيانكا.
الأسئلة التي استوقفتني:
• دلالة تكرار ذكر اسم الطبيبة أكثر من مرة.
• التركيز على تكرار نجاسة الكلب وضرورة الاستنجاء منه والتطهر.
• حاجز اللغة: العلّة المشتركة بين جميع اللاجئين.
• ما هي القناعة التي تجعل الإنسان لا يجد حرجاً عند معاقرة الخمر والنساء، بينما يركّز على ضرورة التطهر من نجاسة الكلب؟ مع أنّ عظمة ذنب الخمر والنساء تأتي في المرتبة الأولى قبل ذنب تربية كلب ولمسه.
هل بالفعل ثمّة أمان في بلاد الغربة؟
شخصية آلان نقشبندي وحبّه لابنة البعثي: هل كان حبّاً، أم تدنيساً لشرف من لا شرف له؟
وكلمة “حبيبتي” التي قالها لزوجته مرة واحدة، وكمجرد مزحة!